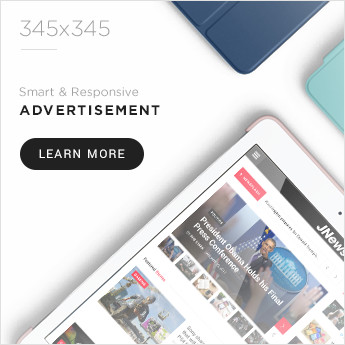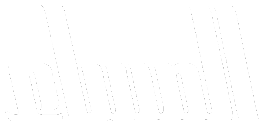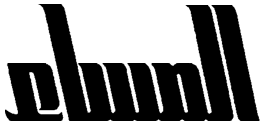عم حنفي السعدني – الاسم مستعار – هو الذى بنى بيتنا بشارع إسماعيل صبري. استأجر أبي فيه شقة بالطابق الثالث، وأقام السعدني – مع أسرته – في شقة بالطابق الثاني.
ولد ابنه هاشم – لا أذكر ترتيبه بين إخوته – في العام نفسه الذى ولدت فيه، تزاملنا في كتاب عم أحمد بشارع فرنسا، وفي مدرسة مصر الفتاة بشارع صفر باشا، ثم في مدرسة البوصيري الأولية بشارع الكناني.
أشد ما كان يثير حنفي السعدني مداعبات أصحاب الدكاكين في شارع إسماعيل صبري لابنه ربيع. لم أعرف ترتيبه بين أبناء السعدني، لكنني وعيت على بنيته الممتلئة، ووجهه المستدير، الأبيض، الذي تناثرت فيه زوائد جلدية، والإصبع الزائدة في كل يد، وقدرته الناقصة عن النطق، فمن الصعب أن تلتقط معظم ما يصدر عنه من كلمات.
لم يكن ربيع يعاني – في الحقيقة – بلاهة، ولا تخلفًا عقليًا. كان” حالة” لها إدراكها، ووسائل علاجها للأمور.
يطل حنفي السعدني على هتاف ربيع، يدافع عن ابنه المحاصر بالكلمات المداعبة. يصرخ من موقعه خلف النافذة:
– بس يا حيوان انت وهوه!
تظل الكلمات المداعبة – لم تخل من قسوة! – على حالها، وإن أضيفت إليها عبارة يتكرر ترديدها:
– العوض على الله الرجل اتجن.. الرجل اتجن!
يغلب الارتباك على السعدني، تتواصل عباراته الغاضبة، لكنها تصطدم باللامبالاة، وتكرار الهتاف المنغم.
بحضور بديهة، يحسب للرجل، يتخلى عن شتائمه، يستبدل بها الهتاف، كأنه واحد من مردديه، ضد شخص ما!
انتقلت أسرة السعدني – بعد ذلك – إلى شارع الميدان، في بناية شيدها الرجل. ظلت صداقتي لهاشم على توثقها، لم تتأثر بانتقال أسرته من شقة شارع الميدان إلى بيت آخر في شارع أحمد كشك، المتفرع من صفر باشا [ أفدت من رحلة آل السعدني في روايتي” زمان الوصل ” ]
حسب رواية أبي، فقد انتقل السعدني في مهنته من البيوت ذات الأعمدة والأسقف الخشبية، إلى البيوت الحديثة المشيدة من الخرسانة المسلحة.
من هنا، كان سؤالي المفاجئ لهاشم السعدني:
– هو والدك بيشتغل إيه؟
قال:
– مقاول.
– أين شركته؟
وهو يبسط ذراعيه:
– عمله في السوق.
تظاهرت بالفهم، وإن ظلت مهنة حنفي السعدني في ذهني محملة بأسئلة كثيرة، مستغلقة، حتى صار رائدًا في صناعة البناء، يشترى الأرض الخلاء، يشيد فوقها بناية من عدة طوابق، يختار لأسرته شقة فيها، ثم يبيعها عمارة كاملة، أو وحدات يجري بيعها وفق قوانين التمليك التي أفرزتها مرحلة الانفتاح الساداتي.
عاشت الأسرة في انتقال من بيت إلى بيت، يسكنون الشقة في البيت الجديد، في داخلهم توقع انتقالهم إلى شقة في البيت الذي يشيده أبوهم.
اشتغل السعدني بمهن مختلفة، دون أن يتخصص في مهنة محددة، ثم صارت له خبرة وكلاء المحامين في أروقة المحاكم، يلجأ إليهم المحامون أنفسهم، فضلًا عن المتقاضين، دون أن يتاح لهم حق الترافع، كانت المقاولات مجال خبرته، يصمم الرسوم الهندسية، وخرائط البنايات، يضعها تحت يد المهندس، يوقع مقابل أجر، ثقة في خبرة المقاول.
ظلت مهنة حنفي السعدني غائبة عن إدراكي، كان بلا مكان عمل يذهب إليه، يقيم غالبية وقته في البيت، مشاويره للتعاقد على شراء قطعة أرض، أو الإشراف على عملية البناء حتى يكتمل البيت، فيبيعه، ويسكن شقة فيه، لأشهر أو لسنوات، ثم يعني بشراء قطعة أرض خالية جديدة، لا يلبث أن يبنى فوقها عمارة جديدة، يسكن مع أسرته شقة فيها، وهكذا..
أعرف المهن التي ترتسم هوياتها في الذهن بمعان محددة: النجار، الحداد، المحامي، الطبيب، الفران، المحاسب، الحلاق، البقال، بائع الأدوات المدرسية. حتى تجارة الجملة لابد أن يخصص لها مكان للتخزين، والإدارة، والتسويق.
لا أذكر متى قرأت – للمرة الأولى – عن مهنة ” الخرمنجي”، عرفت أنه الرجل الذي يأخذ أنفاسًا من السجاير قبل أن تدور بها ماكينة الإنتاج، يحكم على مواصفات السيجارة، إن كانت هي التوليفة الصحيحة، وعرفت أن الرجل المتذوق له وجوده في مهن أخرى, لا تقتصر على السجاير، إنما تمتد إلى الطعام والمنسوجات، وغيرها من مستلزمات حياتنا.
كانت للسعدني طرائقه في تذوق الطعام. يلتقط الزيتونة من البرميل أسفل الفاترينة الزجاجية، يقذف بها في فمه، يغمض عينيه، يمتصها على مهل، يقطع شريحة الجبن التركي (الرومي في تسمية أهل القاهرة ) من فوق القالب المستدير، يقربها من عينيه وأنفه، يتحسسها بإصبعه، يجري عليها بلسانه، ثم يمتص شفتيه. ربما اكتفى من تذوق العسل – عسل نحل، أو أسود – بدس إصبعه في البرطمان، ثم يدسّه بين الشفتين حتى تمتصانه تمامًا. ولأنه من الصعب أكل الخبز دون تقطيعه، فقد كان يأكل لقيمات من رغيف ” الفينو”، ويقول وهو يضع بقيته في يد أحد أبنائه: قيّده على الحساب!
استعدت السعدني – كما قلت – حين قرأت عن وظيفة ” الخرمنجي”، الرجل الذي يقتصر عمله – في مصنع السجاير – على التذوق، إبداء الموافقة من عدمها على صلاحية نوع الدخان لصنع سيجارة. الخرمنجي يتقاضى أجرًا عن عمله. أما السعدني فقد كان أجره هو مجرد التذوق، ما يغريه يتذوقه.
كان الرجل على سعة مادية، لكنه كان يجد سعادة في تذوق الأطعمة بما لا يدفعه إلى شراء كل ما يتذوقه، هو يتذوق ما أمامه، ثم لا يشتري سوى صنفين، أو ثلاثة.
غاب المعنى – ذات عيد فطر – عن البقال، أدرك معنى مغايرًا في تصرف عم حنفي، فعلا صوته بالتوبيخ القاسى.
أطلت الوجوه من النوافذ والشرفات، توقع الجميع رد فعل مماثلًا من عم حنفي، لكن الرجل مسح فمه بظهر كفه، وغادر الدكان، دون أن يتلفت.
أشرت إلى دور عمارة شارع أحمد كشك في روايتي” زمان الوصل”. عدت إليها بعد غياب سنوات طويلة، للتعرف إلى أحوال أسرة السعدني.
فاجأتني، وأحزنتني، شراعة الباب المفتوحة على شقة خالية، لا يسكنها إلا التراب والسكون. استعدت أيام زياراتي للأسرة التي كنت أعتبرها أسرتي، أجد في حنفي السعدني أبًا، وزوجته أمًا، والأبناء اخوتي، وإن ظفر هاشم في نفسى بمكانة تساوي مكانة الأشقاء.
استعادت المخيلة ما كانت عليه الشقة قبل أن تغادرها الأسرة إلى مكان لا أعرفه. أزمعت – وأنا أهبط السلالم من الطابق الثالث – أن أكتب عملًا مستوحى من الحياة القديمة في الشقة، أعيد إلى الحجرات ما كانت عليه، ترددت عليها كثيرًا، فأنا أذكر الكثير من صور الحياة فيها، كل حجرة تروي ما كان، وأتخيل – بإنطاقها – ما انتهت إليه، ماذا حدث؟ كيف، متى؟ هل ظل أفراد الأسرة في شقة واحدة، أو أنهم توزعوا في أحياء المدينة، وربما سافروا إلى خارج الإسكندرية؟
لا صلة لهاشم السعدني بطل ” زمان الوصل” بعمارة أحمد كشك، المطلة على مقام سيدي نصر الدين.. لكن المخيلة الروائية فرضت نفسها، من خلال دلالات، طرحها تفكك أسرة، وتوزع أفرادها بين الموت، والانتقال إلى مدن قريبة وبعيدة.
مضت سنوات كثيرة على غياب حنفي السعدني عن حياتي، لكنني تذكرته في اقتراب عيد الفطر. الجسد العملاق، الوجه القمحي المستدير، الملامح الطيبة، يحاكي أصحاب الدكاكين في شارع إسماعيل صبري، في إيقاع التصفيق، وترديد الكلمات الساخرة، فيفسد المعنى: العوض على الله الرجل اتجن.. الرجل اتجن!