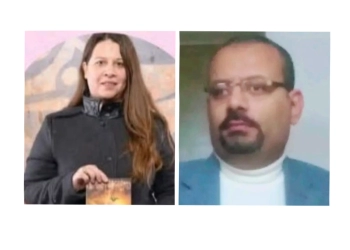بقلم/ أحمد محمد علي
بقلم/ أحمد محمد علي
في مدينة ولدت على شاطئ أسطوري، ونامت قرونا تحت أجنحة الإلهة إيزيس، اجتمعت ثمان عشرة فرقة مسرحية جامعية على مسرح قصر ثقافة الإنفوشي بالإسكندرية، لا لتتنافس فقط، بل لتكشف عن ذلك السؤال الذي لا يكف الإنسان عن طرحه في كل زمان ومكان.
من نحن وسط هذا الضجيج؟
كأن المهرجان مرآة ضخمة نصبت على المسرح، تعكس ملامحنا المتغيّرة، قلقنا الوجودي، وهشاشتنا التي نغطيها بأقنعة التقدم والرقي. كان المشهد كالحلم، دوائر من الضوء تتداخل، طلاب يكتبون على الجدران الظلالية جملا من نور، يعيدون خلق الواقع على الخشبة… لا ليمثلوه فقط، بل ليُفكّكوه، يعيدوا تأويله، ويحاكوا به المستحيل.
ضيق تنفس… حين يباع الهواء بالكريديت!
في “ضيق تنفّس لكلية الزراعة”، لا تتنفس لأنك حي، بل لأن لديك رصيدًا. الهواء صار سلعة، والروح تُباع على هيئة قُبلة مخلّبة داخل علبة شفّافة. العرض بدا كأن أورويل كتب نصّه بعد نوبة ربو، وأخرجه شاب رأى العالم من ماسورة صرف صحي.
محمد السوري كاتبا وأحمد علاء مخرجا لم يقدما مستقبلا متخيّلا، بل مرآة لحاضر جاف، يباع فيه الشعور بالإعلانات المنولة، وتستبدل الأحضان بالكودات. والطفلة التي تقرأ كانت الأمل المتبقّي في أن القصص لا تزال تُنقذ ما لا تُنقذه السياسة.
المصباح… تيسلا والاعتذار المتأخر
نيكولا تيسلا خرج من قبره ليروي لنا أن العبقرية وحدها لا تكفي. تحتاج إلى سُلطة، إلى جمهور، إلى من يعرف كيف يبيعك على منصات التواصل الاجتماعي. معتز عجمي مؤلفا ومصطفى صلاح مخرجا لم يصنعا عرضا، بل قدما اعترافا من طلاب الجامعة الأهلية الواعدين.
“نحن مجتمع ينسى من لا يعرف كيف يُسوّق نفسه”.
القبور على جانبي المسرح، المقاعد التي ترسم اسم “تيسلا”، العيون التي لا ترمش… كل شيء كان صدى لرجل اخترع النور، ولم يستطع أن يُنير حياته الخاصة. عرض المصباح هو مرثية تكنولوجية في زمن الحشود، هو رسالة حب إلى كل عبقري منسي، ولكل مشاهد قرأ السيرة الخطأ.

نجع أسفيت… هاملت يشرب من النيل
في عرض أحمد أمين وشروق وجدي المعد عن واغش رأفت الدويري قدمت كلية الطب البشري شخصيات لا ترتدي تيجان الدنمارك، بل عباءات الصعيد. الحكاية حكايتنا، والدم دمنا، والثأر لا يُحلّ بالمنطق بل بالرصاص. دهشان، الراوي الكفيف، لم يكن دليلنا فقط، بل كان شاهد العمى الجماعي الذي أصاب مجتمعات قررت أن تنام في الحكاية بدلا من أن تستيقظ منها.
“نجع أسفيت” كان لوحة مشقوقة بين “هاملت” و”الزير سالم”، حيث القبر هو البيت، والذاكرة هي سلاح الجريمة.
في “دماء على صخرة الحكمة” المعد عن وادي العميان لهربرت ويلز ومن إخراج أواب شبانة، يستيقظ “چوزيه” في بلد العميان، لا ليبصر، بل ليدفع ثمن البصر. في عالم يُقدس العمى، لا مكان لمُخلص يرى، العرض يحاكم “العلموية” كما يحاكم الجهل، ويرسم لوحة دامية لزمن لا يتحمّل المختلف حتى لو كان المنقذ.
أما “الهوا الأصفر” عن رائعة ملحمة السراب لسعد الله ونوس، والتى قدمتها كلية التربية فقد كان خرائط خراب بلدةٍ أسطورية، تسلّم مفاتيحها لخادم أخرق وشيطان وسيم. النساء يُباعن في سوق الوعود، والصرح يتحول إلى ناطحة رأسمالية، والأبطال يقفون على الأطلال ليصفّقوا لانهيارهم. سعد الله ونوس كان سيبتسم لهذا العرض، وربما يبكي أيضًا.
وفي “المسألة” قدم محمد عبد القادر لكلية الحقوق رؤية مغايرة، فجعل “هاملت” يتجول بين المهرجين، ويُعلق على حبل من الأسئلة. العرض كله صراخ داخلي، أكروبات ووجوه مطليّة، سيرك يمثل المجتمع في مشهديّة سريالية لا تهدأ.
المخرج يهمس، ربما نحن نرتدي كل يوم وجه مهرج… وننكر ذلك.
فمن يرى حقًا؟!
هل البصيرة لعنة؟ هل من يرى يصلب؟ هل من يحلم يُسحق؟
المهرجان كله كان جوابا بصيغة السؤال، كأننا في طقس قديم تستدعى فيه الأرواح لترقص على أنقاض الوطن.
هذه العروض لم تكن فقط عروضا مسرحية تتنافس، بل رسائل مشفرة، كتابات على الحائط، صفارات إنذار على وشك أن تُقرع. كان المسرح، بكل عفويته وارتباكه ومجده، هو النبي الأخرس الذي صرخ أخيرًا.
الإسكندرية رأت، والشباب قالوا كلمتهم
“لن نكون مجرد كومبارس في مشهد يكتبه غيرنا… نحن نكتب، نحن نحلم، نحن نُبصر.”