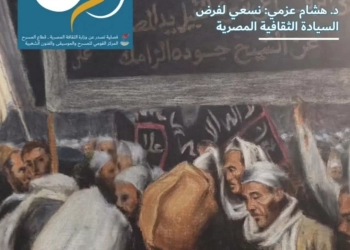ويتجدد اللقاء مع إبداعات مواهب وأدباء أبناء أرض الكنانة ،وضيفتنا في السطور الأديبة الواعدة جومانة فرج سالم والتي أهدت بوابة “الجمهورية والمساء أون لاين”، قصتها الجديدة التي وسمت بـ” حِبر وثلجٌ ودخان”.
🍂
حِبر وثلجٌ ودخان
السابعة صباحًا.. بينما أسند كلا ساقَيَّ على حافة سريري بزاويةٍ معيّنة،
أثناء جلوسي على كرسيٍّ مجاورٍ له، وشبّاكي مفتوح نصف فتحة.
صوت المروحة التي تتحرك يمينًا ويسارًا في السقف، والموسيقى الهادئة التي اخترتها بعشوائية يدندنان في اذني .
بيدي اليمنى سيجارة أشعلتُها بصعوبةٍ بأعواد الكبريت التي وجدتها في حقيبة صديقتي التي نسيتها عندي منذ أسابيع.
ليس كما لو أنني أفتّش في أغراض غيري، ولكنها تعرف بالفعل أني فتحتُ حقيبتها ووجدتُ علبة السجائر.
لذا قلتُ لنفسي: لا بأس بخلق بعضٍ من الأجواء ، حتى ولو كنتُ أخشى أن يراني أحد،
ربما الجيران بالخارج، ربما الرائحة العالقة بغرفتي جرّاء الدخان.. لا أعرف، ولكني لم أهتم كثيرًا.
في الواقع، ما بداخلي كان يحرقني أكثر من استنشاق الدخان ونفثه.
كنت أراقب كيف يشتعل الورق ببطءٍ ليتلاشى ويتبخر، ثم يتفتت ويتساقط.
في تلك اللحظة شعرتُ أني والسيجارة كيانٌ واحد غير منفصلين.
كلانا يحترق، يتلاشى، يتبخر، ثم يتفتت ويتساقط كالرماد.
تخيلتُ نفسي جالسةً على أحد الشرفات وسط مدينة، تحديدًا في نوريلسك بروسيا.
ولعلك تتساءل: لِمَ اخترتُ تلك المدينة تحديدًا؟
من قد يسترخي في مكانٍ منعزل، منطوٍ، بعيدٍ بأحد زوايا العالم، ومثلجٍ طوال العام،
حيثُ تغيب الشمس لأشهرٍ ويطول الليل لأكثر؟
ربما لأني شعرتُ أني أشبه تلك المدينة.. ألسنا ننتمي عادةً إلى ما يُشبهنا؟
أراقب البنايات التي تم طلاءها بالأزرق والأخضر والوردي عمدًا لتخفيف حدة المظهر الكئيب،
أو لخداع الناس بأن العيش هنا ليس بهذه البشاعة، وإلا فمن سيدير شركات التعدين؟
وعلى الرغم من كونها هكذا، إلا أنها بالفعل غنيّة جدًا وثريّة بمعادن كثيرة،
والدخول إليها صعب… هكذا أشعر أغلب الوقت.
ولكن العكس… العكس تمامًا.
في اللحظة التي استنشقتُ فيها الدخان لأول مرة منذ وقتٍ طويل،
شعرتُ بدغدغةٍ تُداعب رئتَيَّ من الداخل.
شعورٌ مذهلٌ حقًا أن يلمس داخلك شيءٌ غير الضياع.
أردتُ حمل كتابٍ بيدي وقراءته واحتساء القهوة،
ولكن في الواقع لا أحب القهوة ولا رائحتها، لذلك اكتفيت بالماء ، و مراره السيجارة .
أعجبتني الصورة في مخيلتي لا أكثر.
شغلتُ نفسي بدغدغة رئتَيّ والنظر من فتحة الشباك الصغيرة.
أحيانًا أشعر أني لا أستطيع أن أكتب إلا وأنا بهذه الحالة… ضائعة تمامًا.
اقتربتُ من إتمام عامي الثاني والعشرين،
ولم أتحمّس يومًا لعيد ميلادي.
هو فقط تذكرة لي باقترابي أكثر من الثلاثين.
ولكن لماذا أخشى الثلاثين إلى هذا الحد؟
أو ربما أخشى ألّا أحقق شيئًا قبل أن أصل لذلك العمر.
أحيانًا يؤلمني النظر إلى المرآة؛
ما أراه أمامي لا يُشبهني أبدًا… لا يُشبه روحي من الداخل،
ولا ما هو في مخيلتي، لا يُشبه شخصيتي حتى.
أنا عالقة داخل هذا الجسد اللعين.
أرى عينيّ اللتين يزداد إرهاقهما يومًا بعد يوم من قلّة النوم.
وكيف أنام والكوابيس تطاردني كل ليلة؟
حتى المنام لا يبدو لي آمنًا أو مسالمًا.
ابتسمتُ براحةٍ كبيرة، ثم أحرقتُ آخر ما تبقّى من السيجارة ونفثتُه ببطءٍ شديد لأستشعر كل ثانيةٍ به.
أطفأتُها، وأمسكتُ بقلمي بعدها، وها أنا أكتب الآن..
🍂