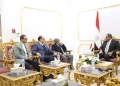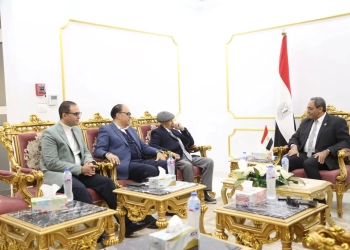بقلم: د. مارينا إبراهيم ميخائيل
(مدرس الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون والاعلام التكاملي ـ جامعة الأهرام الكندية)
في إحدى محاضراتي الجامعية، رفع طالب يده وسألني بصوت امتزج فيه القلق بالدهشة: “دكتوره .. هل فعلاً مصر مش بلد المصريين القدماء؟ يقولون ان حضارتنا لم تكن ملكنا، بل كانت لشعوب اخري!”
كان السؤال صادمًا ليس في مضمونه، بل في توقيته وسياقه، إذ يعكس حجم التشويش في وعي الجيل الجديد. لحظة صمت مرّت في القاعة، لكن في داخلي تردّد سؤال أشد وقعًا: لماذا تحوّلت الهوية إلى مساحة نزاع تديرها المنصات الرقمية أكثر مما تُحسم في الأروقة الأكاديمية؟
أنا لا أكتب هنا كعالمة أنساب، بل كمُتخصصة في الإعلام النفسي، معنية بكيفية إعادة تشكيل وعي الإنسان بذاته تحت تأثير الميديا. فجدل “هل نحن مصريون قدماء أم من أصول إفريقية؟” لم يعد مسألة تاريخية محضة، بل أصبح أزمة هوية تُدار في الفضاء الرقمي، وتُؤطر بمقاطع مختزلة، وصور معالجة، وهاشتا جات تتجاوز قوتها أحيانًا قوة المكتبات.
هوية مختزلة أم رواية مغيّبة؟
لقد بات من المألوف أن نُطرح أمام معادلة خطيرة:
إما أن تكون مصر حضارة فرعونية نقية، أو أنها ثمرة لأصول إفريقية سوداء بالكامل.
وهذا الاختزال الذي يبدو للوهلة الأولى سؤالاً مشروعًا هو في حقيقته تفكيك للهوية الوطنية في أكثر صورها هشاشة.
فالهوية المصرية نُسجت عبر آلاف السنين من التفاعل بين وادي النيل، الشرق الأدنى، أفريقيا الداخلية، وحضارات البحر المتوسط. هي هوية متعددة الطبقات، لا تُقاس بلون الجلد، ولا تُحدَّد بجينوم أو سلالة.
السوشيال ميديا: المسرح الجديد لإعادة تعريف الذات
• منصات التواصل الاجتماعي لم تعد أدوات للترفيه أو التبادل، بل أصبحت ساحات حرب رمزية يُعاد فيها إنتاج التاريخ والبُعد الحضاري من خلال:
• مقاطع فيديو تحمل عناوين مثيرة مثل “المصريون ليسوا المصريين القدماء”.
• صور تماثيل تُعدَّل رقميًا لتتماهى مع سردية محددة.
• ميمات تعيد برمجة الإدراك الجمعي دون الحاجة لأي دليل.
هذه الظاهرة ليست محض صدفة. من منظور الإعلام النفسي، هناك ثلاث آليات رئيسية تُفسر انجذاب الشباب لهذه الروايات:
• الفراغ الهوياتي والحاجة إلى إطار ثابت: في عالم متغير، يتشبث الإنسان بما يمنحه شعورًا بالثبات والانتماء.
• سطوة الصورة في تشكيل الإدراك: صورة واحدة مؤثرة قد تزيح كتبًا كاملة، حتى وإن كانت مجتزأة أو مضللة.
• ثقافة “القبيلة الرقمية”: إذ يلجأ الفرد للمجموعات التي تؤكد روايته، ويعادى من يخالفها، مما يُنتج تحزبات إعلامية أكثر من نقاش معرفي.
ماذا تقول الجينات والتاريخ؟
في مقابل الخطاب العاطفي، تقدّم الدراسات الجينية رؤية أكثر اتزانًا.
دراسة منشورة في مجلة Nature عام 2024 (Saupe et al.)، والتي حللت الحمض النووي لأقدم رفات بشرية من مقابر بني حسن (4500 سنة)، وجدت أن:
77.6% من التركيب الجيني يعود إلى جذور محلية تعود إلى شمال أفريقيا.
النسبة المتبقية تمثّل تفاعلات حضارية مع الرافدين، ولم تُغيّر البصمة الجينية الأساسية.
كما تم توثيق استمرارية السلالة الجينية المصرية القديمة خصوصًا E-M78 منذ ما قبل الزراعة في مصر وحتى المصريين المعاصرين، ما يجعلنا من بين أقوى ثلاث شعوب في العالم في الاستمرارية الجينية على أرض واحدة.
الكحل… موروث منسي في معركة الاعتراف
لا يقف التشويه عند الأسئلة الكبرى للهوية، بل يمتد إلى الرموز الدقيقة.
في خضم الأخبار المتداولة حول سعي بعض الدول لتسجيل “الكحل العربي” ضمن قائمة اليونسكو للتراث اللامادي، يبرز سؤال غائب:
كيف يُنسب الكحل إلى حضارات لاحقة، بينما هو موثق كعنصر يومي وديني وطبي وجمالي في مصر القديمة منذ آلاف السنين؟
إن تجاهل هذا التراث ليس خطأً تقنيًا، بل امتداد لسرديات إقصاء مصر من تاريخها ورموزها.
ليس المهم من أين جئنا… بل كيف نُعرّف أنفسنا اليوم
بدل الانشغال بثنائيات مختزِلة من نوع “مصريون قدماء أم أفارقة؟” علينا طرح أسئلة أكثر عمقًا:
من يصوغ روايتنا الجمعية؟
ما دور الإعلام في تشكيل وعي الشباب؟
ولماذا أصبحت المعلومة المختزلة أكثر تأثيرًا من التاريخ الموثق؟
الهوية ليست تركيبة جينية فقط، بل مشروع وعي، وذاكرة حية، وتراكم ثقافي، وموروث إنساني يصعب محوه أو استبداله.
مصر ليست سؤالًا… بل مشروع متجدد
مصر لا تُختزل في لون، ولا تُعاد كتابتها بتغريدة.
مصر حضارة نشأت من استقرار، لا من عبور؛ ومن تنوع، لا من عزلة؛ ومن الوعي، لا من الادعاء.
وفي زمن يتعرض فيه وعي الشعوب لإعادة صياغة شبه يومية، يظل دور المثقف والأكاديمي ليس فقط في الدفاع عن السردية، بل في تفكيك التشويش، وإعادة تعريف الانتماء، وتحصين الوعي بجرعة عقلانية وسط عواصف العاطفة.
فالانتماء ليس صراخًا، بل معرفة. والفخر لا ينبع من لون البشرة، بل من إدراك التاريخ وفهم الذات.