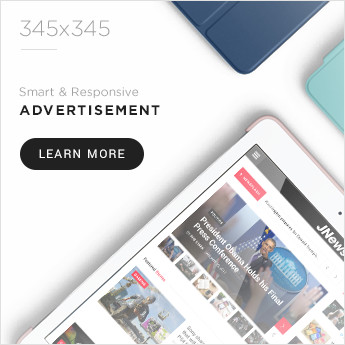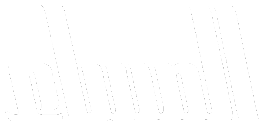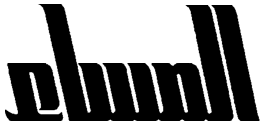محمد جبريل
رائحة المكتبات تختلف عن غيرها من الروائح التي تقبلها، أو ترفضها، لكنها تنقلني إلى العالم الذي أعشقه: طاولات القراءة، أرفف الكتب، الفاترينات وأوراق المسودات والطباعة، الأحبار، دوران المطبعة. أشعر أني أحيا في عالم حقيقي تفتح وعيي عليه، سرت فيه خطوة بعد أخرى، حتى تشكلت ملامحه في ذهني.
أذكر ترددي – في مطالع أيامي القاهرية- على دار المحفوظات بالقلعة. أرقى المدق الصاعد إلى الباب الخشبي الضخم، الحائل اللون، المغلق. أضغط الجرس. يترامى – من الداخل 0 رنين الجرس، يعكس ارتطامه بالجدران صوتًا مغايرًا لأصوات الأجراس بتعدد أماكنها. أستعيده الآن، يبدو متفردًا في رنينه.
كان قرب مقهى متاتيا من سور الأزبكية – والعكس صحيح – تأكيداً للصلة بين الكتاب وقرائه. لا أعرف متى بدأت ظاهرة السور، لكنه – فى تصورى – مثّل استجابة لبحث رواد متاتيا عن كتب للقراءة.
ربما كانت البداية فى بائع متجول، مثل الشيخ إبراهيم بائع الكتب الضرير فى الفيشاوى وما جاوره من مقاهى ومحال حى الحسين، ومثل الباعة الذين يحملون رصّات الكتب على أيديهم، ويتنقلون بين المقاهى، يجدون فرصة الراحة فى دعوة للفرجة، يأذن صاحب المقهى، فيضع البائع رصة الكتب على طاولة المقهى، ويتنهد.
بداية سور الأزبكية – كما تجمع الكثير من الروايات – فى مطلع القرن الفائت. السبب الأهم اقترابها من تجمعات المثقفين فى مقهى متاتيا، الذى كان يرتاده جمال الدين الأفغانى وتلامذته من مثقفى العصر، وفى مقاهى شارع محمد على، والشوارع المتفرعة من ميدان الأوبرا، بالإضافة إلى جامع الأزهر، ومكتبات حى الحسين.
أنت تفطن – بمجرد أن تبدأ في تقليب الكتب – إلى أن الخبرة التي وضعها البائع في عينيه، تتابعان تصرفاتك، وملامحك، وما إذا استبدلت الكتاب بآخر، أم أطلت تقليبه، والتنهد – مرتاحًا – بما يعني أنك عثرت على ما تبحث عنه، لا تفوت البائع شاردة ولا واردة، وهو ما ينعكس في فصاله.
لا تظهر اللهفة في متابعة تقليب البائع للكتاب الذي تريده. حاول أن تظل ملامحك ساكنة، أو تبدي اللامبالاة.
إذا كان الكتاب مصادفة التقليب، فإن البائع يعرض ما يغري بالاقتناء. أما إذا نطقت عيناك بالحاجة إلى الكتاب، ولا يشكل ارتفاع سعره عائقًا دون اختياره، فإن البائع قد ينزل السعر الصادم قروشًا قليلة، وغالبًا فأنت ترضى، رغم ثقتك أنك ستدفع أكثر مما لو لم يلتقط اتجاه نظراتك. الحاج محمد مدبولي لم يكن يعرف القراءة، يقتصر في تثمينه الكتاب بالنظرة المتفحصة، والتقليب باليدين.
لعلك تحتاج إلى صداقة بائع، أو أكثر، من العارضين في السور، إنهم يخفون المطبوعات المصادرة، أو قليلة النسخ. لابد أن تهمس باسم الكتاب، وتعد بالسعر الذي تراه مناسبًا، تمتد يده إلى الضلفة المغلقة، وتعود بالكتاب. وفي زياراتي إلى مكتبة مدبولي، كنت أجاوز فرشة الرصيف، والكتب المعروضة في واجهة المحل. أصعد الدرجات القليلة داخل البيت، أميل إلى اليمين، أبحث في الأرفف عن الكتب التى يقتصر وجودها – لسبب أو لآخر – على الشقة الواسعة.
بالإضافة إلى سور الأزبكية، المعلم الأهم لبيع الكتب فى القاهرة، فقد اعتدت التنقل بين أكثر من كشك، أو فرشة، لبيع الكتب الجديدة والقديمة: مدبولى فى ميدان طلعت حرب، الفرشة الملاصقة لسور جروبى طلعت حرب، الكتب المصفوفة إلى جانب مدخل البناية الكبيرة بشارع قصر النيل، كشك دور النشر اللبنانية أسفل كازينو صفية حلمى بميدان الأوبرا.. وغيرها. وعندما اختفى ذلك كله، لم يعد من الأيام الجميلة إلا الذكرى.
أهمل شاب صديق لي – في ندوة المساء الأسبوعية – ما يحتاج إليه بيع الكتب من خبرة قد تعوزه. بسط فرشة للكتب التي لا يحتاج إليها على رصيف دار القضاء العالي. عاد إلى البيت – في نهاية اليوم الثالث – بلا كتب، ولا نقود. تعددت زيارات عسكري الساحة، يأخذ منه ما يتقاضاه من عائد كتبه. تلاشت الكتب، كما تلاشت النقود!
***
لا أغالى حين أقول إن المشكلات التى واجهها سور الأزبكية هى المشكلات نفسها التى واجهها سوق النبى دانيال بالإسكندرية. بل إن مشكلات الكتاب، أعنى تسويقه، تتعدد فى عموم القطر المصرى، لكنها تصب فى المعنى الواحد، وهو الظروف القاسية التى يعانيها الكتاب فى مصر، ليس على مستوى القارئ الذى يطلبه، وإنما على مستوى المسئول الذى يجد فى الكتاب عيباً ينبغى مداراته.
لم أجد مقهى للمثقفين قريبًا من النبى دانيال، مثلما كانت متاتيا قريبة من سور الأزبكية. تصور الصلة بين سوق النبى دانيال والمقهى يغيب، بحيث يلح السؤال عن البداية الحقيقية للسوق.
إلى أوائل الستينيات من القرن الماضى، لم يكن لسوق النبى دانيال وجود، وإن كانت هناك متاجر منفردة فى الشوارع المحيطة.
أذكر دكانًا أقرب فى سعته إلى المخزن، فى مواجهة الباب الجانبى لمبنى سنترال محطة الإسكندرية. بضاعته ألوف الكتب، حديثة وقديمة. اشتريت منه طبعة الكتاب الذهبى لروايتى نجيب محفوظ “خان الخليلى” و” زقاق المدق”. وثمة خردواتى خلف سينما “ستار” ( الدورادو )، خصص الواجهة لبيع، وإعارة الكتب القديمة، وإعادتها. قل ترددى عليه لإصراره أن يكسب – فى الكتاب الواحد – ثلاثة أضعاف ثمنه!
لم أحاول، ولا فكرت، في أن أستبدل البيع بالشراء عند باعة الكتب القديمة في النبي دانيال وما حوله. كنت أستطيع مغالبة الظروف على نحو ما، لكن غربة الحياة القاهرية دفعتني إلى التصرف في كتب، توهمت أنها سترافقني إلى نهاية العمر!
***
مكتبات الأكشاك والأرصفة والجدران ظاهرة جميلة فى مدن العالم، لا مدينة – تقريبًا – تخلو من تلك المكتبات، والناس يقفون أمامها، يشاهدون، يتصفحون الكتب، يدفعون قيمة ما اختاروه، ويمضون.
لأن النظافة فى بلادنا بلغت حدها الأقصى، فلا ذرة تراب فى الطريق، ولا ورقة تتطاير فى الهواء، ولا ماء آسن يشكل بركًا، ولا بصاق، ولا نفايات، فإن المسئولين يحرصون على أن تظل النظافة فى صورتها المثلى، يزيلون أى أثر للكتاب، باعتباره ظاهرة سلبية تسيء إلى مظهر المدن المصرية.
ولأن ضفتى النيل تشهدان رعاية دائمة، متجددة، تناقض الإهمال الذى تعانيه ضفاف السين والفولجا والدانوب وغيرها من أنهار المدن الكبرى فى العالم، فإن إدراك المسئولين لما ينبغى فعله، يدفعهم إلى إلغاء كل ما يشوه الحياة على ضفتى النهر، وباعة الكتب بخاصة.
إذا كانت مسئولية المجتمع توفير الطعام كغذاء للبطون، فإن مسئوليته كذلك أن يوفر الكتاب كغذاء للعقول.
غذاء العقول – فى تقديرى – له السبق باعتبار أنه يقتصر على التلقى، أما العقل فهو يتلقى ويعطى، يحاول توفير الطعام، مثلما يحاول تلبية احتياجات الإنسان الأخرى.
قيمة العقل هى المدخل، والقراءة هى أول ما دعت إليه الذات الإلهية، وكما تقول الآية الكريمة: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
أتصور أن رئيس هيئة التنسيق الحضارى سافر إلى أكثر من مدينة أوروبية، وشاهد المكتبات فى الميادين، وعلى جدران البنايات، وضفاف الأنهار. لذلك فإن صمته على المعاملة القاسية التى يواجهها الكتاب فى المدن المصرية تدينه شخصيًا، كمواطن مثقف قبل أن يكون مسئولًا!
أخيراً، فإنه بدلًا من أن نلقى السؤال: لماذا يختفى الكتاب؟.. فإن علينا أن نستبدل به السؤال: لماذا لا نحرص على وفرة أماكن بيع الكتاب؟