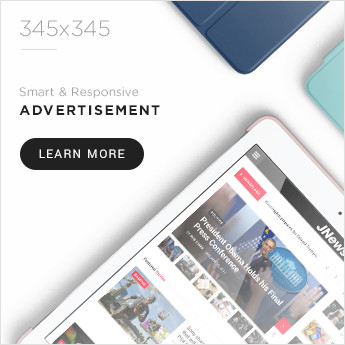✍️ أحمد رفاعي آدم ” أديب وروائي”
……..
أحد أبرز الفروق بين المعرفة الفلسفية والعلمية لدى اليونانيين في العصور القديمة والوسطى وبين المعرفة العلمية في العصر الحديث هو أن الأولى كانت قائمةً بشكلٍ كبير على التفسير العقلي للظواهر دون المساس بالجانب المادي التطبيقي، في حين أن علوم العصر الحديث تأسست على مناهج البحث العلمي المنَظَمة من تنظير وتجريب وتطبيق وصولاً إلى النتائج الملموسة، وقد لخَّصَ الفيلسوفُ الإنجليزي فرانسيس بيكون تلك المقارنة في القرن التاسع عشر بقوله: “لقد اقتصر الفكر حتى الآن على تفسير العالم على أنحاء شتى، ولكن المهم هو تغييره.”
نعم .. ليس تفسير العالم فقط هو الغاية بل تغييره للأفضل والأصلح بتعميره وتطويره، وهو مبدأ خلافة الإنسان في الأرض، ذلك المبدأ الذي أقره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين قال: “وإذ قال ربُك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة.” وإذا كان الهدف الحقيقي للتفكير العلمي هو تغيير العالم للأفضل وتحقيق سيطرة الإنسان عليه فإنه من الضروري دمج النظرية والتطبيق بحيث لا تكون إحداهما بمَعْزِلٍ عن الأخرى من أجل تحقيق تلك الغاية النبيلة.
من خلال ما تقدَّمَ يمكن الجزْم بأن إحدى أكبر مشكلات التعليم في بلادنا تتمثلُ في مُعضِلةِ الفصل بين شِقي العلم؛ أعني المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ولذلك عدة أسباب.
أولُها عدم وضوح رؤية التعليم، فكثيرٌ من قضاياه ومشكلاته المعاصرة لا تزال قائمةً بلا حلول أو دون حتى محاولة الاقتراب منها واقتحامها، باستثناء بعض أنماط التعليم الدولي الذي يعتمد في الأساس على المصروفات العالية. ولا شك أن تفاقم تلك المشكلات وتناميها جعل مهمة الإصلاح عسيرة جداً.
سببٌ آخر وراء ذلك الشِقاق بين النظرية والتطبيق يكمنُ في فصلِ التعليم عن سوق العمل، بحيث أصبح من الصعب أن يتحصل خريجو الجامعات على وظائف ثابتة أو أعمال دائمة تُسهم في عجلة الإنتاج القومي وتُشبِعُ لديهم حاجة الشعور بالذات، وهو ما تسبب بدوره في تفاقم مشكلة البطالة.
أضِف إلى ذلك ضياع هيبة التعليم لدى عدد غير قليل من الأجيال الجديدة، بمعنى أن قداسة العلم والسعي في تحصيله وتبجيل العملية التعليمية بأكملها باتت مجرد خيالات لا تمت للواقع بصلة، وقد أدَّى ذلك إلى عزوف كثير من طلاب العلم عن المُذاكرة والاجتهاد وتطوير الذات بحُجة ألا فائدة من ذلك ولا طائل، وهي قطعاً نظرة خاطئة. فالعلم ليس مجرد شهادات – كما هو للأسف شائعٌ الآن – بل هو علوم ومعارف ومهارات وقدرات يكتسبها الإنسان لفلاحه وصلاحه ونجاحه في المهمة الموكلة إليه وهي عمارة الكون. فالعلم غاية ووسيلة، غاية بإدراك معارفه النظرية ووسيلة بتسخير تطبيقاته العملية لتحسين الحياة لكل المخلوقات.
ألا يكفي طالب العلم شرفاً ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه؟ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَن سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له مَن في السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضلُ العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، إنما ورَّثوا العلم، فمَن أخذ به أخذ بحظ وافرٍ)). رواه أبو داوود والترمذي وصححه الألباني.
أخيراً وليس آخراً تأتي مشكلة البحث العلمي الذي أضحى في كثير من الأحيان مجرد حِبر على ورق بقصد تحصيل شهادة علمية وليس بقصد اكتشاف مجهول أو تطوير قديم أو اختراع جديد. نظرةٌ سريعة إلى العدد الهائل من الرسالات العلمية لا سيما في الكليات النظرية في جامعاتنا لندركَ أن المسافة شاسعة والبونُ كبير بين النظرية والتطبيق، بين القول والفعل، بين مجرد تستيف الأوراق وإجراء التجارب داخل المختبرات والقيام بالإحصاءات. للأسف الشديد غالباً ما تفتقر أمثال تلك الدراسات والأبحاث لأدنى درجات الفائدة العملية والتطبيقية على أرض الواقع.
إذاً .. كيف نُعيد الصلة بين النظرية والتطبيق في تعليمنا؟ البداية تأتي بتغيير القناعات التي سيطرت على عقول القائمين على التعليم ومن في فَلَكِهم يدورون. لابد من إقناع هؤلاء بجدية الأمر وإبراز أهيمة ربط التعليم النظري بعلومه المختلفة بالواقع والتطبيق العملي الفعال بحيث تتحقق الفائدة المرجوة من كل علم. فدراسة الطب مثلاً لابد أن تنعكس على اكتشاف مُسببات الأمراض ومعرفة تفاصيلها من أجل صناعة العقاقير والأمصال التي تقضي عليها وتحمي الناس من مخاطرها.
يجب أن نؤمن بأن دراسة الطب لا يجوز لها أن تتوقف عند علاج الأمراض باتباع ما توصل إليه غيرُنا فنكون في الصفوف الأخيرة التي تنتظر الشفقة والإحسان. وهل ننسى ما كان أثناء أزمة كورونا حين أعلنَ العالم المتقدم الحرب ضد ذلك الفيروس المجهول فرصَدَ العلم والعلماء والمعامل والمختبرات والإمكانات والطاقات لمجابهته، بينما وقفنا نحن موقف المتفرج الذي لا حيلة له سوى انتظار المصير الذي يصنعه له غيرُه؟! يومها بحق أدركنا قيمة البحث العلمي.
مثالٌ آخر نعيشه اليوم ونلمسه بأنفسنا في أزمة زيادة أسعار اللحوم والدواجن بسبب غلاء الأعلاف التي نستوردها من الخارج. أليس من العيب أن تكون عندنا كل تلك المدارس والكليات الزراعية ثم نعجز عن تصنيع الأعلاف بأنفسنا؟ ما الذي ينقصنا ليتصدر من أبنائنا من يقومون بتطبيق العلوم النظرية التي درسوها ويخرجوا علينا بحلول عملية لتصنيع أعلاف المواشي والدواجن والأسماك في بلداننا؟ لو أن دراستهم قامت على التطبيق أكثر من الحشو النظري لهان الأمر.
باختصار .. لا علم حقيقي ولا تعليم فعال بدون ربط النظرية بالتطبيق. نحن بحاجة ماسة لفكر تربوي تعليمي جديد وخارج صندوق النمطية والتقليد الأعمى. لنصنع بأنفسنا تعليماً يناسب احتياجاتنا ويحقق الاكتفاء الذاتي ويخدم الوطن ويدفع عجلة الانتاج إلى الأمام.