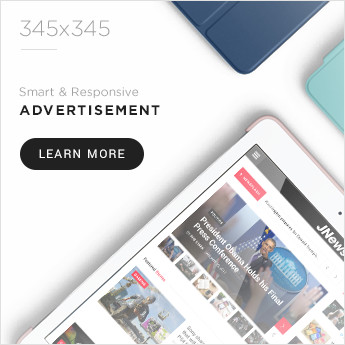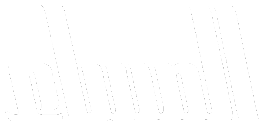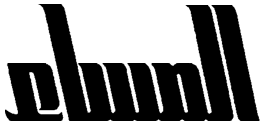بقلم ✍️ أحمد رفاعي آدم
(أديب وروائي)
لا شيء أجمل من الوفاء، فالدنيا ببلاويها وهمومها التي لا تنتهي تهون بكلمة حلوة أو معروف طيب أو لمسة وفاء.
أذكر في طفولتي أنه كان في بيت سيدي عبدالرحمن (لفظة “سيدي” تُطلق في الصعيد على الجد من جهة الأم، أما “جدي” فهو أبو الأب، ولست أعرف السبب!) المهم .. كان في بيت سيدي عبدالرحمن (كما تحكي أمي) في الحريزات الغربية بسوهاج كلب بلدي، لا إفرنجي، وكنا نسميه ريكس. كان ريكس كلباً قوياً كثيف الشعر أبيض اللون يشبه إلى حدٍ كبير فصيلة ال Wolf الآن، وكان ذا مواهب متعددة ومزايا كثيرة من أبرزها وفاؤه الذي جاوز كل الحدود حتى بات مضرب المثل.
ذات مرة كان خالي شعبان -رحمه الله- مسافراً إلى مصر (القاهرة) حيث كان يقضي جيشه (أي خدمته العسكرية)، وكان السفر ليلاً، والليلُ في الصعيد في تلك الأيام الغابرة كان معناه الظلام الدامس والطرقات الخالية والصمت الموحش إلا من أصوات كائنات الليل من نقيق ونعيق (صوت البوم) ونباح وضُباح (صوت الثعلب) وعواء. ولإن القطار يمر بالمدن فقط كان لِزاماً على خالي أن يقطع الطريق من الحريزات الغربية إلى مركز المنشاة حيث المحطة مشياً (إذ تنقطع المواصلات بعد العِشاء بقليل) مخترقاً الغيطان والترع والجسور وصولاً إلى الأسفلت ثم مروراً بقرى الحريزات الشرقية والعَصَّارة والهَمَّاص والباجية والبواريك (أرجو أن يكون الترتيب صحيحاً) (مسافة تتجاوز الخمسة كيلو مترات) قبل بلوغ المركز نفسه. ولك أن تتخيل خطورة مشوار بهذا الطول وفي تلك الأجواء.
تحكي أمي فتقول:
خالك يا ولدي شال شنطته على كتفه وتوكل على الله بعدما سلّم علينا. سِتّك الله يرحمها (طبعاً ستي هي زوجة سيدي) ألحَّتْ عليه أن ينتظر طلوع الفجر لكنه أصرَّ على السفر حتى لا يتأخر عن موعد تسليم نفسه في الكتيبة. وأنت تعرف يا ضنايا قلب الأم. ولما كان سيدك شيخ كبير والمشوار طويل يهد حيله لم تطلب ستك منه أن يذهب مع خالك، لكنها ووسط ذهولنا مضت إلى ريكس الذي نهض من نومته تحت الجميزة التي كانت أمام الدار احتراماً لها فمسحت على فروته وقالت برجاء: ما تروحش أنت يا ريكس مع شعبان توصله؟ وكأن الكلب فهم طلبها فإذا به يتمطى (يتمطع) فارداً رجليه الأماميتين حتى كاد بطنه يلامس الأرض ثم هز ذيله وفتح فمه وأخرج لسانه كأنما يخبرنا بجاهزيته. وبالفعل لم يُكَذِّبْ خبر! فما أن تحرك خالك حتى تبعه ريكس، وخرجنا من الدار ووقفنا على رأس الحارة ننظر ماذا يكون منه، فما أذهلنا إلا سيره الوئيد بجوار خالك حتى انتهيا إلى الطريق الزراعية ثم غاصا سوياً في الغيطان المظلمة.
تكمل أمي فتقول:
وذهب ريكس مع خالك إلى المحطة بل واصطحبه حتى باب القطار، وربض على الرصيف في ركنٍ منزوٍ. فلمَّا بدأت عجلات القطار تتحرك نهض ريكس كأنما يودع خالك الذي جعل يزعق فيه من شباك القطار مطالباً إياه بالرجوع للبيت بعد أن ألقى إليه برغيف خبز. فحمل الكلب الرغيف في فمه ثم قفل راجعاً إلى الحريزات بمفرده. لم يتردد ريكس في القيام بمهمته ولم يفشل فيها. كان كلباً وفياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكان وفاؤه بالأخص لستك التي كانت تطعمه ولا تبخل عليه بشيء فأخلص لنا جميعاً وكان نِعمَ الحارس والمصاحب والمنبه لأي خطر من أول خطر الثعالب التي كانت تسيح في الليل بحثاً عن دجاجة شاردة وانتهاءً بخطر اللصوص والهجامة الذين كانوا يسرقون البهائم من الزرائب.
عاش ريكس عمراً مديداً وكان له من مواقف الوفاء الكثير حسب روايات أمي وأخوالي. منها مثلاً أنه كان دائماً يصحب عمي رجب بعد انتهاء سهراته في بيت سيدي عبد الرحمن بمنطقة (شِق الرملة) حتى يوصله إلى بيت جدي آدم غرب البلد ناحية “جامع الشيخ صبيح”، ولا يتركه حتى يطمئن إلى دخوله البيت فكان عمي يرمي له بكسرة الخبز ويقول له (روِّح يا ريكس!) وقد امتد وفاء ريكس ليشمل حتى الجيران فكان مثلاً لا ينام إلا في صندوق سيارة الحاج عبد الحافظ النقل طوال الليل كأنه يحرسها فكان الرجل يكافئه لذلك ويجزيه خيراً.
وهكذا ظلَّ ريكس مثالاً للوفاء وحسن العِشرة وجمال الصُحبة إلى أن مات غدراً على أيدي بعض المغتاظين (كلمة فصحى) الذين سمُّوه برغيف محشو تقلية (تسبيكة صلصة الطماطم مع البصل) وقطعة لحم. ولإنَّ جزاءَ الوفاءِ وفاءٌ مثلُه، لم تُلقى جثة ريكس في الترعة أو على الأسفلت البعيد كما كانت العادة أيامها، بل تم دفنه في غيط سيدي عبد الرحمن بالنجيلة.
لقد عاش ريكس في زمنٍ ساد فيه الوفاء وطغى حتى فاض على الحيوان والنبات والجماد .. فيا حسرتنا على زمانٍ عزَّ فيه الوفاء بين البشر.