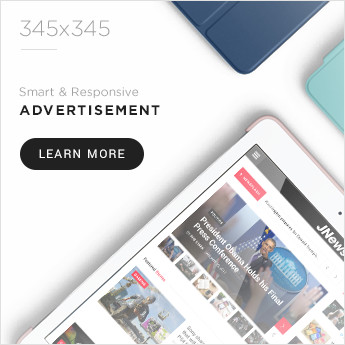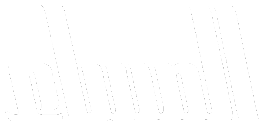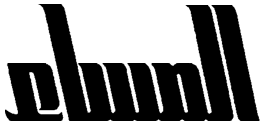أثق أن الدهشة، أو الاستغراب، وربما الضحكة الساخرة، هي رد الفعل الذي ستواجه به الكلمات التي سأكتبها حالًا، وقد تنطق – مشفقًا – باسم المبنى في مفترق شارعي صلاح سالم وامتداد رمسيس( عباسية!).
أصارحك أني استنكرت في نفسي مجرد الخاطرة. الولايات المتحدة؟!، فلما قلبت الأمر، وحاولت تمعن الصورة جيدًا، وجدت أن المشكلة تبدو – في صورتها الظاهرة – بلا حل. ما تطلبه لإنهاء خمسة وسبعين عامًا من الاحتلال حلولًا غير تقليدية، تضع في اعتبارها قوة الكيان، المحتل الذي تواجهه، والكيانات التي تسانده، بداية من الولايات المتحدة، وانتهاء بدول الغرب الأوروبي، مرورًا بجزر مجهولة ضمتها واشنطن إلى عضوية الأمم المتحدة، ليرفع ممثلوها أيديهم بالموافقة على ما يمليه مندوب ولي النعم في البيت الأبيض.
أخطر ما في السياسة الأمريكية أن مجالاتها السلبية تتسع، بداية من استخدام الفيتو في مجلس الأمن، امتدادًا في استغلال هيمنتها على حلف الناتو، فالقرارات تصدر بالأهواء والتآمر والرغبة في فرض الوصاية، وليس وفق ما تمليه الاعتبارات الإنسانية والقانونية على مستوى العالم. آخرها – كما تابعنا عبر القنوات الفضائية – فيتو المندوب الأمريكي في مجلس الأمن ضد قرار بإيقاف الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، لأسباب إنسانية، تزامنًا مع دعوة وزير الخارجية بلينكن دول العالم إلى احترام حقوق الإنسان، ومطالبته – في الوقت نفسه – بأن تواصل القوات الإسرائيلية تدميرها للحياة في غزة، وفي ما تبقى من أرض فلسطين، وتمنيه ألّا يتجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين حدًا أعلى.
خلطبيط!
حتى لا أتوه بك في تعبيرات غير محددة، فسأحاول أن أسجل نقاطًا، توضح، أو تومئ بما يقرب المعنى.
لابد من الإقرار – بداية – أن الصندوق الانتخابي هو الذي يحكم الولايات المتحدة. مفتاح الصندوق – عبر العقود الأخيرة – في يد اللوبي الصهيوني. وعدم إطلاق فترة الهيمنة الصهيونية على الصندوق الانتخابي، وعلى سير العمليات الأمريكية بتعدد مستوياتها، لأن الصورة في عهد الرئيس الأسبق أيزنهاور – مثلًا – لم تكن كذلك. فقد فاز في انتخابات الرئاسة رغم معارضة اللوبي الصهيوني. وكان لإنذاره – إلى جانب إنذار الزعيم السوفييتي بولجانين – تأثيره في انسحاب إسرائيل من سيناء، بعد أن شكلت في عدوان 1956 على مصر قوة تابعة لفرنسا وإنجلترا، ووجد بن جوريون في الانسحاب المصري من سيناء ما يغري يضمها إلى بلده، لولا وقفة أيزنهاور الصارمة، في موازاة الإنذار السوفييتي بالمعني نفسه.
تكوين آخر في المشهد، يمثله اللوبي الصهيوني الذي أفلح، من خلال منظمة إيباك، ذات السيطرة علي المراكز المهمة للإعلام الأمريكي، أن يفرض كلمة نافذة على الصندوق الانتخابي الأمريكي.
الصندوق الانتخابي هو الذي أملى على الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب إعلان شطري القدس – تجاوزًا للقرارات الدولية – عاصمة لدولة إسرائيل، وأبدى الرئيس الحالي بايدن اعتزازه بالحركة الصهيونية، وأنها لو لم تكن موجودة لاخترعها، أما وزير الخارجية بلينكن، فقد قال – من خلال أداء مسرحي مؤثر – غداة الهزيمة التي ألحقتها المقاومة بالجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر – إنه قدم إلى تل أبيب لا بصفته وزير خارجية الدولة الكبرى في العالم، وإنما لديانته اليهودية، ولأن جده – يا عيني ! – عانى ويلات التعذيب النازي!
نستطيع – وفق هذه النظرة – فهم تلاحق أوامر القيادة السياسية الأمريكية بالوقوف إلى جانب إسرائيل من خلال زيارة سريعة من بايدن، ودعوة رؤساء الغرب إلى زيارات مماثلة، كما دفعت واشنطن حاملتي طائرات ومدمرات وقاذفت صواريخ وعربات مدرعة، وساندت الجيش الإسرائيلي الذي اقتنعنا بأنه أكبر قوة عسكرية في المنطقة المسماة بالشرق الأوسط ( هي الوطن العربي، وليست الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسمية سخيفة تستهدف تبديل الثوابت. ثمة بلدان مثل إيران وتركيا، تشكل مجاورة لأقطار الوطن العربي، ولا تدخل في صميم نسيجها القومي). ساندت الجيش الإسرائيلي بكتائب من النخبة لدعمه في الحرب ضد تنظيم مجال تحركه قطاع لا تعدو مساحته بضعة كيلو مترات، يشكل جزءًا من دولة محتلة، اقتطع الاحتلال أكثر من 80 % من مساحتها.
وتحدث الرئيس الأمريكي عن فزعه لرؤية 40 طفلًا يهوديًا فصلت المقاومة أعناقهم، مشهد ينافي أبسط المبادئ الإنسانية، ولأن الكذبة كان يعوزها الدليل، فقد اضطر بايدن – في اليوم نفسه – إلى العدول عن تصريحه المثير، وأنه لم يشهد ما يدل على قتل أطفال، ولا أي مدنيين!
تحدث بلينكن وتابعوه من وزراء خارجية دول الغرب عن حق ” المختطفين” اليهود في غزة، وعن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ورأى في عمليات الإبادة التي تشنها تل أبيب على فلسطينيي غزة أمرًا مقبولًا، ووافق عليه، على أن يؤخذ في الاعتبار- حسب قول الوزير الأمريكي – أرواح المدنيين قدر الإمكان.
المثير للتأمل، وللغضب، أن بلينكن تجاهل حق شعب فلسطين في الحياة داخل حدود بلاده، التي كانت من قبل أن تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة. كما تجاهل عشرات الألوف من الشهداء والمصابين الذين قتلهم الدمار الإسرائيلي، بدعوى أنه يحارب مقاتلي حماس.
التعبير اللغوي الصحيح أن المعتدى عليه، مالك البيت والأرض والشجر والتاريخ والجغرافيا، من حقه أن يدافع عن نفسه. وهو ما ينطبق على الفلسطينيين، وليس على الوافدين من بلاد في الشرق والغرب، وحدة الديانة هي مبرر اغتصابهم الوحيد وطن الغير.
مع اختلاف الظروف، فقد كرر بايدن وبلينكن ما شهده الصراع العربي الإسرائيلي منذ خمسين عاما. عبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية للقناة بما لم تحسن رئيسة الوزراء الإسرائيلية الإصغاء إليه، بدت نهاية الحلم الاستيطاني وشيكة، وهاتفت جولدا مائير وزير الخارجية الأمريكي اليهودي هنري كيسنجر: انقذوا أرواحنا، نحن أقل من ضعفاء. الكلمات ذكرتها جولدا في ذكرياتها!. وتصرف كيسنجر، كما تصرف بلينكن بعد خمسين عامًا، تعددت زياراته إلى المنطقة، حاول كسب الوقت، إلى جانب فتح الترسانة الأمريكية على أحدث أسلحتها. السيناريو نفسه، رغم تغير الظروف.
لعلك تصورت – في لحظات كثيرة – أن قيادة العمليات العسكرية في واشنطن وليست في تل أبيب، من يلقي الأوامر هو الرئيس بايدن، ويتولى التنفيذ مجلس الحرب الإسرائيلي.
الأمثلة كثيرة، طالعتنا في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، أذكرك بواقعة ذبح أربعين طفلا إسرائيليا، قال الرئيس الأمريكي إنه شاهد صورهم بنفسه، ثم ترك لهيئة مكتبه نفي الواقعة، وأنه لم ير شيئًا!.
للصورة – كما تعلم – تكوين آخر يخلو من الافتعال والزيف والوقائع المكذوبة.
أذكرك بالبيان الذي وقعه أربعمائة من كبار موظفي الخارجية الأمريكية، يعيبون على المسئول الأول في الوزارة انحيازه غير الموضوعي لإسرائيل، مما يسيء إلى صورة الولايات المتحدة في العالم، ويشكك في صحة تدخلاتها السلمية لحل الصراعات الدولية.
ولعل من أخطر الظواهر اتهام مئات المتدربين في البيت الأبيض رئيس البيت بأنه لا يصغي إلى ملاحظات مواطنيه المتعلقة بالحرية في العالم، وكانت الجرائم النازية في غزة – من قبيل التوحد بالمعتدي – هي المنطلق. وامتدت الملاحظات لتوجه إلى الرئيس اتهامًا بأن قراراته لصالح إسرائيل كارثة في السياسة الأمريكية. من هنا يأتي فهمنا لتصريح بلينكن بأن بلاده فوجئت بالهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد المدنيين العزل، وأنها كانت تتوقع حمايتهم. كلام يصعب تصديقه، لأن من يأخذ موضع العضو الرابع في مجلس الحرب، بمعنى أنه شارك في اتخاذ قرارات المجلس، فضلًا عن الرئيس الذي يدلي بالبيانات الإعلامية المتوالية بهمة مكتب إعلامي، تبرر سواد خيمة الدمار التي غطت سماء غزة. حتى وزير الدفاع الأمريكي اضطر – اتساقًا مع الرأى الشعبي الغلاب – لإدانة المذابح الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. وتوعد بلينكن المستوطنين الذين اقتحموا حياة فلسطيني الضفة بالموت والدمار، أنه سيعاقبهم بعدم منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
منتهى القسوة كما ترى!
مع ذلك، فقد جاوز المتحدث عن البيت الأبيض كل ما صدر من تصريحات، وأعلن أنه لم يتلق أي دليل على قتل المدنيين في غزة، وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كأنه يمنح الإذن: اقتلوا، ولا تخشوا شيئًا!
ولعلك شاهدت وقفة يلينكن المرتبكة وهو يصغي – مرغمًا – إلى توبيخ مشارك في محاضرة للوزير، بانه يعمل لصالح تل أبيب، وليس لصالح واشنطن.أما المظاهرات التي اخترقت العاصمة الأمريكية، فقد وصفها الإعلام – حتى المحسوب على الصهيونية – بأنها أضخم مظاهرات شهدتها واشنطن، تهتف بنصرة غزة، وحرية فلسطين.ولا يخلو من دلالة فوز مدافعتين عن الحق العربي في انتخابات الكونجرس الأمريكي، فلسطينية وصومالية، أحدث حضورهما البرلماني نشاطًا فاعلًا في نصرة القضية الفلسطينية.بل إن معاداة الممارسات الإسرائيلية – بداية من انتزاع حق الشعب الفلسطيني في أرضه – سياسة معلنة لجماعات يهودية في صلب عقيدتها الدينية رفض قيام إسرائيل.وفي 2018 وقع أكثر من ثمانين شخصية مثقفة غربية مذكرة تذهب فيها إلى أن الواجب الأخلاقي يحفز كل ذي ضمير أن يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن الظواهر الإيجابية اللافتة إدانة رئيسي وزراء كل من إسبانيا وبلجيكا للعمليات العسكرية ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة، وخطاب السيناتور الأمريكي بيرنيساندرز (أتذكر انتقاده – في انتخابات أمريكية سابقة – للنفسية العربية المنهزمة! ) عن منح حكومة إسرائيل 14مليار دولار، بالإضافة إلى أحدث الأسلحة الأمريكية، مقابلًا لإبادة غزة من الخارطة!
وفي بيان متأخر لقصر الإليزيه الفرنسي أعلن رفضه لاتساع عمليات الجيش الإسرائيلي، وأن محاربة الإرهاب – حماس في تقدير الرئيس الفرنسي، ورؤساء غالبية حكومات الغرب تنظيم إرهابي! – لا تكون بالقصف والعمليات الواسعة، فلابد من تطبيق الاتفاقية الأمنية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. الأمر نفسه طالعنا في تصريحات زعماء ومسئولين في دول الغرب. أما جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فقد ظل على موقفه المؤيد للعدالة الإنسانية، وطالب مجلس الأمن بضرورة ممارسة مسئولياته لمنع الكارثة.
كل هذه التطورات – كما أتصور – تشكل انفراجة في الباب الذي نستطيع فتحه عن آخره من خلال وجود فاعل في مراكز صنع القرار الأمريكي. السياسة هي فن الممكن، وما نتحدث عنه ليس مستحيلًا. فقط لو أن العرب فطنوا إلى الطريق الصحيحة، وما فيها من مؤشرات نحو الغاية المطلوبة.
اللافت أن عملاء الصهيونية في المطبخ السياسي الأمريكي تنبهوا إلى خطورة النذر التي توضحت عقب وقفة الرأي العام في الولايات الأمريكية، وفي عواصم الغرب، فضلًا عن مدن أخرى كثيرة في العالم.
كان ترامب قد أمر بمنع تأشيرات الدخول عن مواطني مدن محددة إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، أما الدعوة الجديدة بإغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة أمام أبناء الوطن العربي، فإن تفسيرها الوحيد هو التنبه إلى النذر التي توضحت، بداية من 7 أكتوبر.
إذا كان اللوبي الصهيوني قد أفلح في زرع الوهم داخل العقلية السياسية الأمريكية، بأنه العنصر الأشد تأثيرً في الصندوق الانتخابي، فإني أذكرك بفوز أيزنهاور بالرئاسة، في تجاوز لضغط اللوبي الصهيوني، كما أذكرك بأخطر الأسئلة التي واجهت الساسة الأمريكان أيام توالي هزائم القوات الإسرائيلية في حرب 1973: إذا انهار البناء الذي شاركنا في تشييده، ودعمه، فما معنى – في ضوء المصلحة الوطنية – مواصلة الحرب دفاعًا عن حليف منهزم؟