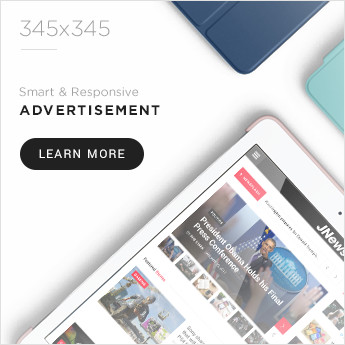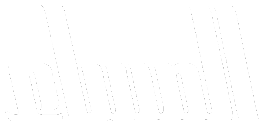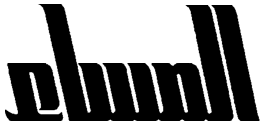القاهرة مدينة مزدحمة، زحامها فاق كل دراسات الخبراء وتخطيطاتهم. قيل إن خبيرًا يابانيًا قدم لدراسة ظاهرة الزحام في مصر المحروسة [ بالمناسبة: القاهرة – في التسمية القديمة – هي مصر المحروسة ] وبعد أن تعرف الخبير اليابانى إلى أبعاد الأزمة على الطبيعة، وقرأ، ودرس، وحلل، قال في نبرة جادة: يصعب أن أقترح إضافة إلى محاولاتكم لحل أزمة الزحام، ما تفعلونه – أمام شدة الأزمة – هو أقصى المتاح.
ولأن المرء هو الذي يساعد نفسه على اكتساب العادة، ويحفّز العادة لأن تصبح تكوينًا في شخصيته، فقد حرصت – من زمن لا أذكره – أن أكون دقيقًا في مواعيدي، لا أصل في الموعد المحدد تمامًا، لكنني أسبق الموعد بما يتيحه لي سوء الظن بوسائل المواصلات. قد أضع تصورًا زمانيًا، المسافة بين المكان الذي أبدأ منه، والمكان الذي أنتهي إليه. يصدق التصور حينًا، ويفشل أحياناً كثيرة.
إذا أعطيتني موعدًا، فإني أعتبره دقيقًا. أحرص عليه بالدقيقة والثانية. أعد نفسي في فترة كافية، ثم أتجه إلى مكان اللقاء قبل الموعد، خشية الزحام وتأخر وسائل المواصلات. أتمشي حول المكان حتى يأتي الموعد.لا قبل ولا بعد. ذلك هو التعبير الذي كان ديستويفسكي يرفق به تحديد مواعيده.
في صالون حلاقة بروض الفرج – قصدته لحلاقة رأسي – أدركت مصرية الوقت، الوقت عند المصريين له معنى مغاير، هو المعنى الذي نختزله في الوصف “موعد فلاحين”، تحديد المواعيد بتوقيتات النهار والليل، وليس بالساعة التي تنظم عقاربها وقت الإنسان، لا يصبح – على حد تعبير أحمد بهاء الدين – سداح مداح، إنما هو ساعة “بيج بن” الشهيرة، تحدد لنا أوقاتنا بالثانية والدقيقة والساعة.
أسلمت رأسي – أيام الطفولة والصبا – إلى عم عبد السلام، الحلاق أسفل بيتنا، تردد على بيتي في القاهرة – للفعل نفسه – الأسطى أبو الهمم، ثم سافرت خارج مصر، وعرفت – بعد العودة – أن ” أبو الهمم” رحل إلى جوار ربه.
لم أحاول أن يكون لي حلاقي الخاص، أقرأ اللافتة فأقول: نعيمًا، وأدخل.
قلت لحلاق روض الفرج:
– لديك وقت؟
قال في انشغاله:
– خمس دقائق!
جلست حتى مضى نصف ساعة. أظهرت التململ:
– انتظاري تجاوز الوقت!
نهضت مستأذنًا. لحقني دليلي إلى المكان صديقي الشاعر يسرى حسان. غالب صوته إشفاق:
– لا تتعامل مع المواعيد بصرامة!
لكن تلك نظرتي إلى المواعيد، إلى الوقت. إذا احترمنا المواعيد فنحن نحترم الوقت!.
أذكر كتابًا قديمًا، يتحدث فيه مؤلفه – لعله كارنيجي – عن كيفية الحفاظ على الوقت، فلا نبدد حتى لحظات الانتظار على محطة الأوتوبيس، نصح المؤلف أن يشغلها المرء بقراءة كتاب. أفادتني النصيحة جيدًا، ولأن القراءة في حياتى، فقد حاولت أن أشغل نفسي بقراءة كل ما تصادفه عيناي، أقرأ في كل شيء.
أختلف مع صديقي عبد المنعم السلموني في أن أوقات الصغر لا يشغلنا انتهاؤها، لأن تركيزنا ينصب على أن نعيش أوقاتنا، لا يشغلنا إن سرقنا الوقت. أما أوقات الكبر، الشيخوخة، فإن الإحساس بالوقت يكون ثقيلًا، كأنه لا يمر.أذكّر السلموني بإشفاق كازنتزاكس على ما بقي من وقت عمره، فتمنى لو أتيح له – حتى ينجز مشروعه الإبداعي – تسول بعضًا من أوقات الآخرين. وحين بدأ في آخر كتبه ” رسالة إلى الجريكو” تواصلت دعواته بأن يمد الله في عمره عشر سنوات، حتى يفرغ من كتابه ” عشر سنوات تكفي، هكذا أعتقد”. وكان يقول: أشعر برغبة في أن أنزل إلى الطريق، أمد يدي إلى المارة، أتسول من كل منهم ربع ساعة!، يذكرنا بقول إدجار ألان بو: إن الإنسان لا يكاد ينمو حتى يقطف.
المثل يقول: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، وهو مثل – رغم جهارته – صحيح تمامًا، والدعوة الغريبة التي تسود حياتنا بأن نقتل الوقت في لعبة، أو دردشة. لن نقتل الوقت، لأننا – في لحظة ما – نمضي، ويبقى الوقت أزليًا. وحين نزمع قتل الوقت فإننا – على نحو ما – نقتل أنفسنا، نأخذ من رصيد حياتنا تحت مسمى قتل الوقت!
أجاد الفراعنة التعامل مع الوقت، إلى حد معرفة اللحظات التي تهبط فيها الشمس عمودية على معبد رمسيس في أسوان. مع ذلك، فإن إهمال المواعيد لم يعد مقصورًا على الحياة في القرى، لكنه امتد ليصبح – للأسف – عادة مصرية.
أكره تعبير قتل الوقت. نحن لا نقتل الوقت، ولا نستطيع. الوقت هو الذي يقتلنا ليظل شاهدًا على أيام السابقين، وعلى أيامنا، وأيام الأجيال التالية.
اللافت – في معظم مؤتمراتنا – أن موعد الجلسة الأولى يبدأ بعد موعده، ويمتد فيأكل فترة ندوتين، ويجور على وقت الندوة التالية التي يضطر منظموها إلى الفعل نفسه، وينتهي الأمر إلى تأجيل الندوة الأخيرة، أو إلغائها.
نحن – كما أشرت – نصف شخصًا بأنه فلاح في مواعيده، يتفق على المواعيد، لكنه يتأخر عنها. الفلاح يعطي الموعد في توقيت لا شأن له بالساعة التي نعرفها، ونلجأ إليها. وتوقيت العصرية كده، أو المغربية كده، يعني عدم ثبات الموعد عند وقت محدد. العصر يبدأ من رفع الأذان إلى رفع أذان المغرب، ليحل موعد آخر إلى رفع أذان العشاء، هكذا نسعى إلى لقاءاتنا في توقيت أداته الشمس.
ومن تقرير سري للسفارة البريطانية قبل 1952: مصر بلد تستطيع أن تجيب فيه على أي سؤال بالقول: بكره إن شاء الله!
الوقت خارج المنافسة، حسب التعبير الشائع. إنه يرافقنا منذ البداية، ويودعنا عند الرحيل، لا يتأثر بأحوالنا، ولا بمحاولاتنا لمغالبته. أذكر قول فوكنر في ” الصخب والعنف “: ” إن الوقت يموت مع كل تكة من رقاص الساعة، ولن يعود الوقت للحياة إلا عندما تتوقف الساعة”.
يسأل فرانكلين: ألست تحب الحياة؟.. ويستطرد: إذن لا تبدد الوقت، لأنه المادة التي صنعت منها الحياة. وكان نابليون يعتز بأنه هزم النمساويين لأنهم لم يقدروا عامل الوقت.
كان نجيب محفوظ من أشد أدبائنا إدراكًا لقيمة الوقت. الشوارعية التي وصف بها مرحلة الشباب لم تسلب وقته. روي صلاح أبو سيف أن نجيب محفوظ كان يأتي قبل خمس دقائق من مواعيد لقاءاتهما، ويظل واقفًا أمام مكان اللقاء حتى يحل وقت الموعد، فيدخل. وفي مقالة لصديق محفوظ القديم، الكاتب محمد عفيفي، تحدث عن قيمة الوقت في حياة محفوظ، النظام الذي فرضه على أوقاته، بداية من مغادرة البيت إلى العمل الوظيفي، حتى المعاش. بعد أن ترك الوظيفة، وفاز” الأهرام” باسمه واحدًا من كبار كتابه، كان يخرج في الموعد نفسه إلى مبنى الأهرام، مرة كل أسبوع، وإلى مقهى في وسط البلد، يخلو فيه إلى قراءة الصحف والتأملات وكتابة الملاحظات في بقية الأيام. سماه محمد عفيفي في مقالته رجل الساعة، بمعنى أن وقته مرتبط بالساعة، لا مجال للأوقات التي اعتدناها في مواعيدنا: نلتقي الظهر، أو العصر، أو بعد العشاء. كل شيء بالدقيقة والثانية.
سواء كان هو المنصت أو المتكلم، فإنه كان ينهض من جلسته في مقهى عرابي، يرفع يديه إلى صدغيه محييًا بطريقته المعهودة، ويمضي. نعرف أن الساعة هي الثامنة تمامًا، موعد انصرافه إلى جلسة الحرافيش.
أذكر – في لقاءاتنا اليومية بقصر عائشة فهمى – نقرة الساعي على الباب، ثم دخوله حجرة المكتب وفي يده القهوة. يضع الفنجان أمام نجيب محفوظ، ويمضي.
قلت للساعى:
– ألاحظ أنك تأتي بالقهوة دون طلب من الأستاذ نجيب!
أشار الساعي إلى ساعة الحائط فوقنا، وقال:
– الساعة اتناشر.
أضاف نجيب محفوظ لدهشتى المتسائلة:
– هو يعرف موعد تناولي القهوة!
أساء البعض فهم حرص محفوظ على النظام، تصوروا أن الرجل يستدعى ” الإلهام” بإرادة صارمة، وفي مواعيد محددة، لا دقيقة تنقص ولا دقيقة تزيد. وهذه العادة قد تصح في علاقات الفنان بالآخرين، ولكن من المستحيل أن تتحقق في علاقته بالعمل الفني. الفن لا تصح معه قرارات من أي نوع، الأديب لا يستطيع أن يجلس إلى قلمه وأوراقه – دون استعداد نفسي أو ذهني – لمجرد أن ذلك هو موعد الكتابة الإبداعية. الإبداع قد يأتي في أى وقت، بمناسبة وبلا مناسبة، حين يخلو الأديب إلى نفسه، أو وهو يجالس الآخرين. أنت تستطيع أن ” تؤطر” علاقتك بالآخرين، لأنه من الميسور مخاطبتهم، وإقناعهم بوجهة نظرك أو إقناعك بوجهة نظرهم.
أما اللحظة الإبداعية، الإلهام، الوحي، فإنها مسميات لمعنى – لا لشخص أو لقيمة مادية. الفارق بين الإبداع والعمل – في تقدير نجيب محفوظ – أن الإبداع لا يخضع لمواعيد ولا قواعد ولا تخطيط. إنه يأتي فجأة وربما بلا تمهيد، في الطريق أحيانًا، أو في العمل، أو على مائدة الطعام، أو في الحمام. وقد يأتي والإنسان بمفرده أو وهو مع الآخرين. أما العمل- أي عمل- فهو يحتاج إلى نظام، العمل الذي يبدأ بالاستيقاظ من النوم، وينتهي بالعودة إلى النوم!.. الموظف – على سبيل المثال – لن يستطيع أن يوفر وقتًا للكتابة إلا بالنظام، بحيث يفرغ للكتابة في غير وقت العمل، ويلتقي بأصدقائه في وقت آخر إلخ”.
ظل نجيب محفوظ حريصًا على ذلك البرنامج، وإن ألزمته – أحيانًا – وعكة صحية لتأخر في مغادرة البيت، أو استبدل مقهى بآخر. هو رجل الساعة، رجل النظام الذي يعرف قيمة الوقت، فلا يأذن لأي طارئ أن يسلبه.
نظام يثير الغيظ بالفعل!