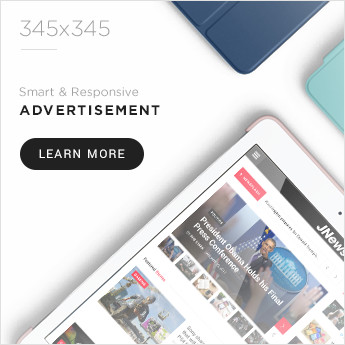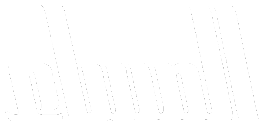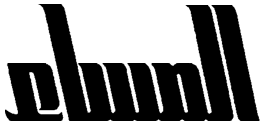بعد فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، نشطت – كالعادة – وسائل الإعلام في تغطية نبأ فوز أول أديب عربي بالجائزة العالمية، وأجرى صديقي الراحل د. حامد أبو أحمد حوارًا مع أديب نوبل، قدمه – معتزًا – إلى جريدة إسبانية يومية، لا أذكر اسمها، لكن الجريدة أعادت الحوار إلى أبي أحمد، بتشكك في أن ما تضمنه من آراء صدر عن محفوظ. وفزت – صحفيًا – بنشر الحوار في” المساء”.
كان رفض الجريدة الإسبانية نشر الحوار دفاعًا عن تيار الواقعية السحرية، الذي وشت كلمات محفوظ برفضه.
الواقع – كما ثبته الحوار – له منطقه، وحدوده التي يصعب مجاوزتها. وهو رأي يسم بالسلب أعمال الواقعية السحرية التي كانت واسطة مبدعي أمريكا اللاتينية للفوز بجائزة نوبل، وغيرها من الجوائز العالمية. إذا أراد الفنان مجاوزة الواقع، فثمة حيل فنية داخل أسوار الواقع، أهمها الأحلام والكوابيس والفصل المتعمد – تتيح له التحليق في أجواء العجائبية والغرائبية. وهو ما عبر عنه محفوظ – في حواراته وكاتب هذه السطور – بالمضمون الواقعي في شكل سوريالي.
” المصداقية” – هذا هو التعبير الذي يحضرني – تكوين ثابت في نظرة نجيب محفوظ إلى العمل الإبداعي، بصرف النظر عن جنسه الفني. إذا جاوز إطار المنطق فإنه يلجأ إلى الحلم أو التخيل. منطق العمل الفني من داخله، وليس بإملاء الفنان.
أذكر اتصال نجيب محفوظ بي – عقب المقالات الصحفية التي تلت عرض مسرحية صمويل بيكيت” لعبة النهاية” – رفض الرأي أن بيكيت غابت عنه دلالات المسرحية، كما غابت عن المتلقين، ومنهم النقاد. وجلست إلى محفوظ في مكتبه. أنقل تلخيصه لأحداث المسرحية، وما تومئ إليه من دلالات تنفي الغموض، أو التلغيز.
لابد من الحدوتة.
وعلى الرغم من حرص نجيب محفوظ على الواقعية الطبيعية بالمعنى الذي ورثه عن بلزاك وزولا وديستويفسكي – أستاذه الأول – وفلوبير وستندال، فإنه عبر في العديد من أعماله – بحكم الانتماء إلى بيئة لها خصوصيتها وتفردها، وسمتها الإنساني في الوقت نفسه. إنها لا تلجأ إلى الغرائب والعجائب لمجرد إحداث الدهشة في وجدان المتلقي، وإنما تتحرك على مستوى البيئة التي ينتمي إليها، بكل زخمها الحضارى والثقافي.
تعرف أحمد عاكف ( خان الخليلي ) إلى مخدر الحشيش، في سهرة الجيران، الأصدقاء، وحلق أنيس زكي ( ثرثرة فوق النيل ) في سماء الضباب الأزرق. عرض الفنان ما حدث دون وساطة فنية. هذا ما حدث، وهو يحدث في البيئة التي يصدر عنها، ويتجه إليها، لا خروج فنيًا عما ألف مشاهدته، والعيش فيه، ومحاولة التعبير عن معطياته.
في ” خان الخليلي” دار عباس شفة بالجوزة خمس مرات متعاقبة، وتصاعد الدخان من كل جانب وانعقد سحبًا، وشم أحمد عاكف رائحة غريبة أثارت ذكرى قديمة، ذكرى راحة تشابه هذه الرائحة، بل هي نفسها دون غيرها. فأين شمها؟ ومتى؟. ولم يطل به عذاب التذكر، فذكر أولى لياليه بخان الخليلي.. ذلك الحي العجيب الذي لا يبعد أن تكون جميع الأنفاس المترددة في جوه من هذه الأنفاس. وسر للذكرى، وارتاح إليها، لأن التخدير كان قد أخذ يسري في أعصابه المتوترة فيلينها. وأصغى على قول مشارك في القعدة: الحشيش سلطان، يوجب على مواليه الخشوع والسكون، بالهدوء والصمت يبلغ التخدير مداه، فيصفو المزاج، وتنثال على الخيال الأحلام، فيظفر الإنسان بمشكلات يومه ومتاعبه، ويحسن التفكير فيها، وحلها واحدة بعد أخرى. رأى أحمد عاكف من حوله عبر نفثات الدخان” فخالهم أشباح دنيا غريبة، أو سكان كوكب آخر، ولا يدري كيف ملأه ذاك الإحساس بالغرابة.. واعتدل في جلسته ليستعيد – ما أمكن – شيئًا من يقظته. وحدث عند ذاك شيء عجيب، نهضت عليات الفائزة قائمة، استطال الجسم الهائل في الفضاء، واشتد طولًا وعرضًا، فملأ الأعين”.
أما أنيس زكي في” ثرثرة فوق النيل” فقد نظر إلى النجوم، يحصي منها ما يستطيع عده، ويرهقه العد، حتى ينساه في رؤية هارون الرشيد جالسًا على أريكة، تحت شجرة مشمش، والجواري يلعبن بين يديه، ويدور حوار، لم يرو فيه أنيس زكي ما يتوقعه الرشيد، فكاد يأمر بقتله، لولا أن جارية غنت على أوتار العود ما أطرب الرشيد. ويستعيد الرجل – في ضبابية السطل! – أيام المماليك. وليدة قراءات تشوشت في الذاكرة، فالغبار يثور لوقع سنابك الخيل، وصياح المماليك بالفرحة في رحلة الرماية ، كلما عثروا على آدمي في مرجوش أو الجمالية جعلوا منه هدفًا لتدريباتهم، ويضيع الضحايا وسط هتاف الفرح المجنون، ونواح الأمهات الثكالى، والأبناء الذين أفزعهم ما رأوا.
قدم أنيس زكي إلى مدير عام المحفوظات مذكرة بحركة الوارد. رأي الرئيس أسطرًا مكتوبة بوضوح، يليها فراغ أبيض. أظهر المدير غضبه، وزاد الغضب لما أدرك أن أنيس زكي كتب أسطرًا، فلما فرغ الحبر واصل الكتابة. ويتهمه المدير بالإدمان ” هذه هي الحقيقة، حقيقة معروفة للجميع حتى السعاة والفراشين، وأنا لست واعظًا، ولا ولي أمرك. افعل بنفسك ما تشاء، ولكن من حقي أن أطالبك بأن تمتنع وقت العمل عن البلبعة”. وفي العوامة سمته الشلة التي عهدت إليه بإعداد قعدات الحشيش ” وزير شئون الكيف”.
ولنقرأ – استطرادًا – هذا الموقف:” ودبت حركة عجيبة في رئيس القلم، فشملت أعضاءه الظاهرة فوق المكتب، حركة تموجية بطيئة، ولكنها ذات أثر حاسم. راح ينتفخ رويدًا فيمتد الانتفاخ من الصدر إلى الرقبة، فإلى الوجه، ثم الرأس. حملق أنيس زكي في رئيسه بعينين جامدتين، وإذا بالانتفاخ، البادئ أصلًا بالصدر، يتضخم، فيزدرد الرقبة والرأس، ماحيًا جميع القسمات والملامح، مؤلفًا من الرجل – في النهاية – كرة ضخمة من اللحم. ويبدو أن وزنه خف بطريقة مذهلة، فمضت الكرة تصعد ببطء أول الأمر، ثم بسرعة متدرجة، حتى طارت كمنطاد، والتصقت بالسقف وهي تتأرجح”.
بعيدًا عن المشابهة بإبداعات الواقعية السحرية: ألا يذكرك هذا الموقف بالعالم القصصي لمحمد حافظ رجب؟
الموقف الروائي لمحفوظ قوامه قراءات وخبرات، بينما يتخلق الموقف القصصي عند حافظ رجب من واقع الحياة، حياته، اصطدام نفسه المرهفة بالواقع الذي يستنكره، أو يرفضه.
قرأ نجيب محفوظ قصص محمد حافظ رجب. وصفها – في حوار له معي – بأنها سوريالية الشكل، واقعية المضمون. نشرت رأي محفوظ في ” المساء”.
قلت لحافظ رجب:
– ثمة آراء تجد في كتاباتك محاكاة لإبداعات غربية.
قال بعفوية:
-أغنتني حياتي عن محاولة المحاكاة.
أذكرك بأن بيروقراطية رئيس الراوي في قصة محمد حافظ رجب، أملت عليه تصوره في هيئة مكتب، هو الرجل المكتب!