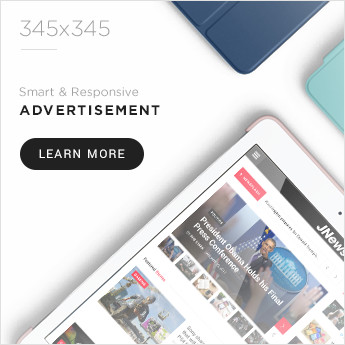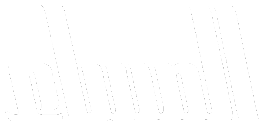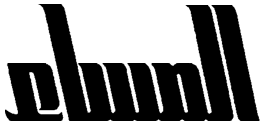كنت قد هجرت مكتبي في ” المساء” لتأثيرات فرضتها عملية جراحية في العمود الفقري. لزمت البيت بوعد أن أعود إلى مكتبي قبل شهر، لكن الشهر أعقبه شهور، أجد في وسائل الاتصال الحديثة تعويضًا ناقصًا عن لقاء الأصدقاء والزملاء والتعرف – عن قرب – إلى تطورات الحياة الثقافية.
لإشفاقي من أن يضم الدولاب وأدراج المكتب ما قد يحزن الأصدقاء فقده، فقد رجوت الصديقين عصام سليمان ويسري حسان أن يتيحا لي مراجعة الأوراق التي كدت أنساها، أو أني نسيتها بالفعل.
كلف الصديقان من أعد الكتب وقصاصات الصحف والملفات والرسائل في ” كراتين”. خلوت إليها في لحظات أترك لك تقديرها إذا عرفت أن انتمائي إلى المساء – هذا هو التعبير الذي يحضرني – يبدأ في نهايات 1959، في مبنى شارع الصحافة ،منذ دخلت المصعد ذي اللافتة ” إثنان فقط وإلّا سقط” شابًا صغيرًا ينشد مجالًا في الساحة الصحفية، باعتبارها وليدًا شرعيًا للكتابة. قلبت ما في الكراتين، هتفت بالتذكر، وأرجعت إلى ضعف الذاكرة ما فرض الحيرة، حتى طالعني مظروف عليه خط أتذكر صاحبه جيدًا: محمد حافظ رجب.
المظروف يحوي مجموعة من المقالات والدراسات النقدية، بعث بها إليّ حافظ – قبل أن ألتزم العزلة – بواسطة صديق سكندري. ولأنه الفنان الذي أعرف قيمته، فقد خاطبت ناشري القطاعين العام والخاص، وطالعني – كالعادة – صمت غير حكيم.
حدثتك – في كلمات سابقة – عن دور محمد حافظ رجب في حياتنا الإبداعية، وأنه لا يقتصر على الصيحة التي أطلقها في الستينيات: نحن جيل بلا أساتذة!
كانت الصيحة تعبيرًا عن موهبة حقيقية، تتلمذت بالقراءة واكتساب الخبرات، لكنها أهملت تلمذة التقليد والمحاكاة، وحرصت أن يكون لها صوتها المتفرد. تذكرنا بصيحة تلاميذ المدرسة الحديثة في مطالع القرن الماضي: نعم للأصالة والمعاصر.. لا للتقليد والمحاكاة!
كان أول ما نشر محمد حافظ رجب فى القصة التجريبية ” المدية “، نشرتها ” المساء ” فى 1963، ثم نشرت ” الإذاعة والتليفزيون ” قصته ” الفارس ” فى العام نفسه. ثم نشرت مجلة ” القصة ” قصته ” الكرة ورأس الرجل “، وقدم لها عبد الحليم عبد الله بكلمات عنوانها ” كاتب من جيل بلا أساتذة “. ثم نشر قصة ” الوشم الوحش ” فى مجلة ” الرائد العربى الكويتية “، وعلق محرر المجلة على القصة بالقول ” إن روح كافكا واضحة فى هذا العمل “. ثم صدر لحافظ العديد من المجموعات القصصية، وترجم ديفيد جونسون بعض قصصه إلى الإنجليزية.
أذكر أني سألت حافظ عن بواعث اتجاهه إلى التجريب. قال: لقد قرأت كثيرًا.. لكن ما أكتبه ينبع من داخلي، لا شأن له بإبداعات الآخرين! وكتب حافظ في الجمهورية ( 3 أكتوبر 1963 ): “قالوا مرة إنني سوريالي. اتهموا كلماتي بالعبث. قالوا إنه نقط حبر فوق نشافة، والحقيقة أننا نكتب ما لم يكتبه أحد قبلنا”. فهل تعنى هذه العبارة أن الجيل بلا أساتذة ؟!
رفض حافظ أن ينسب قصصه إلى هذا المعنى: كتبت بدافع من نفسي، لم يخطر في بالي أن أقلد اتجاهًا ولا مبدعًا، الواقع الظاهري في حياتي محمّل بما لا أستطيع مغالبته، فهو يتحول في كتاباتي إلى هذه الأجواء المتداخلة، الشوهاء والمبتورة.
هذا هو معنى عبارة ” نحن جيل بلا أساتذة ” كما حدثني عنه حافظ. وإذا كان المعنى قد تعدد بالمغايرة في أقلام الكثيرين – حتى حافظ رجب اطمأن إلى معنى مغاير – فإن المعنى هو ما رواه حافظ رجب بعفوية صدقته فيها.
كتب حافظ إبداعاته مهتديًا بموهبته الاستثنائية. لم يصدر عن قواعد، ولا حاول التقليد أو المحاكاة، وإنما كتب ما أملته عليه نوازع الفن. اكتشف حافظ ما في داخله من طاقات إبداعية، فعبر من خلالها دون أن ينظر إلى ما بحوزة الآخرين. يذكرني بقول إدوار يونج إن العمل الأصيل ذو طبيعة نباتية، فهو ينشأ تلقائيًا من جذور العبقرية الحيوية، ثم هو ينمو، فليس هو بالموضوع.
تعرف كبار الأدباء إلى حافظ رجب، وإلى إبداعاته، من قبل أن يجاوز مكانه بائعًا في محطة الرمل بالإسكندرية. وتوالت النصائح بأن حياته الوظيفية في القاهرة أفضل من السعى إلى رزق يوم بيوم فى مدينته الملحية. ولأن الزن على الآذان أمر من السحر، فقد توكل حافظ على الله – ذات صباح، وربما ذات مساء – وسافر إلى القاهرة.
مثّل انتقال الشاب ذي الأعوام الخمسة والعشرين عامًا إلى العاصمة، انعطافة – حسب الكليشيه المتوارث! – في مسار القصة القصيرة المصرية. تباينت الآراء في استقبال أعماله بين الحفاوة والرفض، وإن ظلت تلك الأعمال معلما من المستحيل إغفاله.
قرأنا – في إبداعات حافظ رجب – تعبيرات مثل ” قال الرجل الذي بلا رأس”.. ” مد يده بسرعة، وتناول القرنفلة، وبداخلها أنف المعلق الرياضي، وألقى بها على الأرض، وسحقها بحذائه”.. ” تناول المعلق الرياضىي أنفه المهشم من الأرض، وأعاده إلى مكانه “. شخصيات تذكرنا برواية ” التحول ” لكافكا، عندما يستيقظ جريجور سامسا – ذات صباح – ليجد نفسه قد تحول إلى صرصار، وبكوفاليف في قصة جوجول الشهيرة، حين يستيقظ فى الصباح الباكر ليجد أنفه قد اختفى في أثناء الليل، وحلت مكانه بقعة ملساء، وبيد هومر سمبسون التي جرحت في أثناء محاولته فتح علبة سلمون، فراحت تتلوى على مائدة المطبخ، حتى حملتها اليد الأخرى إلى الحوض، وغسلتها بماء ساخن.. وشخصيات أخرى، تنتمى إلى الأدب السوريالى الذي وصفه أندريه بريتون بأنه ” التعبير سواء بالكتابة أو الكلام أو أية وسائل أخرى عن باطن الفكر، بعيدًا عن تحكم العقل الواعي، ودون اعتبار لأية قيمة أخلاقية أو جمالية”.
في قصة ” جولة ميم المملة ” يقول ميم لأبيه بائع الصحف: أنا لا أعرف توفيق دياب، ولكني أعرف جوركي. أنت تعرف توفيق دياب لأنك بعت جريدته. أنا أعرف جوركي لأني أردت أن أصير مثله. أنت حذرتني من جوركي دون أن تدري. يضيف ميم : مكسيم جوركي مات. لن أصير كما صار. سأتحرر منه كما تحررت من الأب. ويقول لجوركي: لحمى من لحمك يا أبي الثاني.. لكني أتنفس من رئتي أنا !. وفي روايته ” الأنفوشي ” يتحدث محمد الصاوي عن محمد حافظ رجب، فيصفه بأنه فارس بداية الستينيات في القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، وأن معاناته أكثر صدقًا من كافكا، وأنه نبي التجديد في الهياكل القديمة. ووصف فؤاد دوارة قصة حافظ ” البطل ” بأنها أعمق من قصة مشابهة لجوركى، وذهب بعض النقاد إلى أن ما يكتبه حافظ رجب لا يعدو هلوسة كلامية!. لكن حافظ رجب ظل هو الظاهرة الأشد تميزًا بين مبدعى جيله.
إذا استعرت وصف نجيب محفوظ للمهمين من الأدباء، فإن حافظ رجب ينتمي إلى طبقة الفتوات الذين يحسنون توجيه ضرباتهم، بينما يتحدد دور المساعدين في تلقى الضربات. إنه فتوة في جيله، مثلما كان إدريس بين مبدعي الفترة التي قدم فيها إبداعاته، ومن قبله محفوظ في الرواية.. الأمر نفسه بالنسبة لنعمان عاشور في المسرحية، وعبد الصبور في قصيدة الفصحى، وجاهين في قصيدة العامية. وكان رأي يحيى حقي أن أعمال حافظ رجب ستفهم بعد عشرات الأعوام من صدورها، يذكرنا بمقولة ستندال الشهيرة ” سوف أفهم نحو عام 1880 “. وهذا التاريخ يأتي بعد أكثر من ربع قرن من وفاته. ويرجع يوسف الشاروني الضجة التي أثارها حافظ رجب حوله، بصورة أشد مما أثارها الآخرون لأنه ربما كان الوحيد الذي كافح في سبيل نشر أعماله، بينما لم يبذل الفعل نفسه أدباء آخرون، أبدعوا في الاتجاه نفسه الذي أبدع فيه حافظ رجب .
كتبت مرات كثيرة عن محمد حافظ رجب قيمة إبداعية مهمة، ولعله أهم الظواهر في مجال السرد القصصي، منذ مطالع الستينيات، حذرت من أن يدرك من يأتون بعدنا – بعد فوات الأوان – أن موهبة مصرية كبيرة مضت من حياتنا، دون أن تحصل على ما تستحقه من التقدير.
لكن حافظ رجب رحل وسط الهوجة المتكررة من الملتقيات والتكريمات والجوائز، ونعاه العديد من محبيه ودارسيه، وتلقف كلماتهم – كالعادة – وادي الصمت.
.. وماذا بعد؟