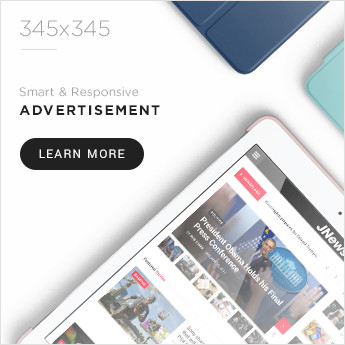أولى قراءاتي لغسان كنفاني روايته” عائد إلى حيفا”. وجدت فيها استشرافًا قاسيًا لمن تغاضوا عن قتل الثور الأبيض، وعبرت عن مشاعري في الكثير من الحوارات، وخوفي من أن أواجه مأساة الزوجين اللذين عادا إلى حيفا عقب نكسة يونيو، للبحث عن وليدهما الطفل، بعد أن ابتلعه الاجتياح الإسرائيلي في نكبة 1948.
حرصت – من يومها – على متابعة كتابات غسان كنفاني، سواء في الإبداع الروائي، أو في الدراسات، أو الكتابات الصحفية.
“في الأدب الصهيوني” كتاب لغسان يعرض فيه للكتابات اليهودية التي عرضت لتطورات الصراع في فلسطين من قبل أن تبين الغزوة الصهيونية عن ملامحها، إلى ما بعد النكسة.
يقدم للكتاب المثقف الفلسطيني الكبير أنيس صائغ. يجد فيه أول دراسة بقلم عربي، وباللغة العربية، في الأدب الصهيوني، أساليبه وفنونه ومراميه السياسية العدوانية، خلال فترة طويلة من الزمن، ومن آثار العشرات من الكتاب الصهيونيين البارزين. والذي دعا مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية أن يكلف غسان كنفاني بوضع هذه الدراسة، وكانت فكرتها ونواتها موجودتين لدى المؤلف من قبل، هو شعور المركز بأهمية درس هذه الناحية المهمة من النتاج الصهيوني التي أغفلها الباحثون العرب ممن حصروا اهتماماتهم في الحقل السياسي فقط من الحركة والعمل الصهيونيين، بالرغم من العلاقة المتينة التي يبيّنها هذا الكتاب، القائمة بين السياسة وبين الأدب في الحركة والعمل الصهيونيين”.
يشير غسان – في البداية – إلى أنه استخدم في دراسته تعبير الأدب الصهيوني، لأنه يخدم حركة الاستعمار اليهودي لفلسطين، سواء في كتابات اليهود، أو في أقلام متعاطفة – لسبب أو لآخر – مع الحلم الصهيوني. وفي تقدير الكاتب أن الحركة الصهيونية قاتلت بسلاح الأدب قتالًا لا يوازيه إلّا قتالها بالسلاح السياسي، ويضغط على أن تجربة الأدب الصهيوني هي الأولى من نوعها في التاريخ، حيث يطوع الفن – في كل أشكاله ومستوياته – للقيام بأكبر عملية تضليل وتزوير، تترتب عليها نتائج خطيرة. فالقول – مثلًا – بأن العرب لم يمتلكوا شيئَا في فلسطين منذ خمسمائة عام، ينفيه – ببساطة – جواز سفر جولدا مائير المثبتة عليه هويتها الفلسطينية!. وتبلغ السيطرة العالمية للإعلام الصهيوني حد منح
جائزة نوبل في الأدب. – نالها كما تعلم – عربي واحد هو نجيب محفوظ – إلى كاتب إسرائيلي، قراء اللغة المشتقة من العبرية، التي يكتب بها لا يزيدون عن بضعة آلاف، وكان حصوله على الجائزة لأنه ” يكتب بلغة عبرية جميلة”؟!
يتحدث الكاتب عن الفترة التي امتدت بضعة قرون ( 175 – 1038 ق.م.) تمتع فيها اليهود بحرية شبه كاملة. لمعت أكثر الأسماء اليهودية أهمية في ميدان الإنتاج الفكري والثقافي الديني، وحقق اليهود ما يعتبرونه الآن استكمالًا للعلوم الدينية والتشريعات التي ما تزال تعتمد حتى الآن، لكنهم – من ناحية أخرى – أكملوا – في تلك الفترة – كتابة التلمود، كتاب العنف الدموي، والحقد، والتطرف. وشاعت أيضًا فكرة العودة إلى أرض الميعاد لأول مرة، ولكن على أسس دينية.
يتوقف الكاتب – عبر صفحات دراسته – أمام ظاهرة اليهودي الجوال. إن صورة اليهودي الجوال – في رأي كنفاني – ترافق الأسطورة ذاتها عند غير اليهود. في الذهن اليهودي كان اليهودي الجوال هو النبي إيليا الذي يدعى في الفولكلور اليهودي، اليهودي الأزلي، والذي كان يلعب في الأساطير الدينية اليهودية المتناقلة دور الخير والإيمان، والدفع نحوهما. وكما يقول علماء الدين اليهود فإنه يوجد 36 يهوديًا تائها لا يموتون، وليس واحدًا فقط. إن رسالة هؤلاء هي المساعدة على الإيمان، مواساة الأرامل والأيتام والعجزة، وإقناع العالم بأن الإيمان وحده سيصلح من شأنهم، وشأن العالم. لكن تلك الرسالة الدينية صارت – في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، رسالة سياسية محضة، بدفع من تيار التعصب اليهودي الذي كان يراهن على الموقع العنصري.
يشير غسان إلى الجهود التي بذلتها الصهيونية بدأب لا مثيل له، لتحويل الديانة اليهودية إلى هوية قومية. فطوال ألفي سنة تقريبًا – القول لكنفاني – كفّت اليهودية عن كونها رابطة قومية، وفقدت كل العناصر التي يشكل مجموعها قومية ما، فلم يكن ثمة رابطة جغرافية ولا حضارية ولا اقتصادية ولا ثقافية ولا سياسية بين يهود العالم، وقبل ذلك كله لم يكن يوجد – بالطبع – أية رابطة عرقية”. هذا القول يذكرنا بدراسة الراحل قدري حفني عن ” التوحد بالمعتدي” والتي ذهب فيها إلى أن الخطر الحقيقي الداهم الذي يهدد أمننا القومي، هو مفهوم الدولة الدينية لقادة إسرائيل، عبر عنه نتنياهو في رسالة إلى يهود فرنسا: “إسرائيل ليست فقط المكان الذي تتوجهون إليه للصلاة، بل دولة إسرائيل هي وطنكم”.
إن مفهوم الدولة الدينية لم يعد ذلك الفهم التقليدي لدولة يقوم نظام الحكم فيها على شريعة سماوية، ولم تعد تلك الدولة التي يحكمها رجال الدين داخل حدودها، كل ذلك لا يضاهي خطر النموذج الصهيوني الذي تطرحه إسرائيل، والذي يعني ذوبان الحدود، وتحول العقيدة الدينية إلى قومية دينية. تقول شخصية روائية يهودية: ” لقد أصبحت عبريًا لأنني أكره اليهودية”. إنه يهودي، ويعتنق الديانة اليهودية، لكن لغتها العبرية يجب أن تظل – في رأيه – لغة دين مقدسة. أما العبرية فهي لغة القومية، وعلى حد قول بن جوريون، فإن العبرية كانت” لغة غير متكلمة، تعيش في القلوب، لأنها كانت لغة الصلاة والشعر والأدب الديني”. وأشير إلى الشعار الذي رفعه آحاد هاعام – أحد رواد الصهيونية – عن آخر يهودي، وأول عبري!
لعلي في هذا السياق أدعوك إلى قراءة كتاب الرائع جمال حمدان” اليهود أنثروبولوجيًا. إنه يقوض الفكرة القائلة بنقاء العنصر اليهودي، وانحدارهم من سلالة واحدة عرقيًا. بالإضافة إلى ما يتضمنه هذا الكتاب من حقائق تاريخية، فإن مراجعة آلاف الزيجات – في العقود الأخيرة – بين مواطنين عرب مسلمين ومسيحيين من يهوديات، سيبدل زعم النقاء العرقي بما قد يغنيك عن قراءة جمال حمدان!
والحق أن المتلقي العربي لم تستوقفه عنصرية الأعمال الفنية التي روجت للفكر الصهيوني، ولا التاريخ اليهودي الذي يعبر – في معظم أحواله – عن وقائع مكذوبة. أضيف – على سبيل المثال – إلى ما ذكره الكاتب من أعمال أدبية فنية، فيلم ” كوفاديس” بطولة فيكتور ماتيور وسوزان هوارد، شاهدته – في صباي – مع الملايين، في دور العرض المصرية. تجرعنا السم دون أن ندري أنه كذلك!.
الأكاذيب بلا نهاية، فالحروب الصليبية وجهت ضد اليهود وليس إلى العرب. عليك أن تصدق هذه الأكذوبة، ولا تسال عن الحروب العربية الصليبية، ولا عن دور صلاح الدين الأيوبي في قيادة انتصار حاسم للعرب على الغزو الصليبي لبلادهم، بل علينا أن نتناسى مقولة اللنبي وهو يقف أمام فير صلاح الدين في القدس: ها قد عدنا يا صلاح الدين!
الكتابات الأدبية الصهيونية تصف العرب بالوحشية اللاأخلاقية، في مقابل التهذيب اللامحدود للإسرائيليين، والذي يتجلى في تعاملهم مع العرب الفلسطينيين. ويذهب السياسي اليهودي البريطاني دزرائيلي – كان روائيًا – في روايته” دافيد آلروي” إلى أن اليهود هم المهيؤون الوحيدون لقيادة الكون، وينقل عن فرويد قوله إن موسى خلق شخصية لليهود حين أعطاهم دينًا أكد ثقتهم بأنفسهم إلى درجة آمنوا معها بأنهم متفوقون على الشعوب الأخرى، واستمرت حياتهم في هذا العالم نتيجة هذا التفوق. كما كتب هرتزل – مؤسس الفكرة القومية اليهودية – رواية بعنوان” الأرض الجديدة القديمة”(هجر إبداعه الأدبي، ليعمل على إنشاء المنظمة الصهيونية ). في هذه الرواية، يذهب هرتزل إلى أن أرض فلسطين المجدبة كانت تستلقي في انتظار اليهود، يصلوها، ويسكنوها، وهو ما قد يذكرك بكلماتي عن المجلة المصرية ” رعمسيس” ( 1910 ) وتأكيدها على عودة اليهود إلى أرض فلسطين، وإلى الوطن العربي بعامة، باعتبارهم – أنقل التعبير – من أصح أمم الشرق نسبًا، لينشروا التقدم في أقطاره. وفي رواية اسمها” الينبوع” للكاتب جيمس ا. ميتشنر ينسب إلى قائد عربي قوله عن حرب 1948 بأنها غزو عربي، أناس قدموا من الصحراء مدهوشين من الزراعات اليهودية، ويصف العرب بأنهم “أكثر الناس قدرة على تدمير الأرض المزروعة، وإحالتها إلى صحراء حيثما ذهبوا، لذلك فهم جديرون باسم آباء الصحراء، بدلًا من اسم أبناء الصحراء”. ويقول اليهودي للعربي وهو يشير إلى أرض مرتفعة: هذه التلة لم تنتج منذ تركها
أجدادنا. لقد أهملتموها، وتركتم مدرجاتها تنهار. سوف ننظف التلة من الحجارة، ونحضر تراكتورات وسمادًا.
ولا تقتصر الكتابات الصهيونية على الإشادة بالتفوق اليهودي، مقابلًا للتخلف العربي، بل إنهم ينسبون إلى مواطنين عرب قولهم إن اليهود هم الخلاص الأوحد للشعب العربي. إنهم الوحيدون الذين جلبوا الضوء إلى هذا الجزء من العالم في الألف سنة الأخيرة. وفي كتابه” موسى والتوحيد” عني فرويد أن يرد ما سماه” التميز اليهودي إلى نوع من الفخار، باعتبار أن موسى وضع اليهود أقرب ما يمكن إلى الله والحقيقة. وقد اتكأت الكاتبة جورج إليوت على هذه النظرية لتدافع عما تراه حق اليهودية في أن تكون قومية، وزاد هرتزل بالقول إن المزج بين الدين والعرق في اليهودية، تحت ظل شعار الله المختار، إنما هو مزج تفيد منه الإنسانية.
أما حلم قيادة اليهود للكون، وليس العالم، فيبين سخفه وسذاجته، في احتياج الكيان الصهيوني إلى من يرعى إنعاشه، بداية من وعد بلفور، حتى الدعم الأمريكي الذي تعتمد عليه إسرائيل بصورة شبه كلية!
وأما الزعم بأن الجندي الإسرائيلي هو أفضل مقاتل عسكريًا وأخلاقيًا في العالم، فإن قطاع غزة، هذا الشريط الساحلي الضيق في أرض فلسطين، ينفي ذلك الزعم، من خلال ما يعانيه المقاتل الأفضل على أيدي المقاومين الفلسطينيين. في يد الإسرائيلي أحدث الأسلحة، وأشدها تدميرًا، بينما سلاح الفلسطيني بدائي بما لا يخفى، صنعه في حصار بالغ القسوة، لا يتيح أي شيء لتواصل الحياة، فضلًا عن صناعة السلاح.