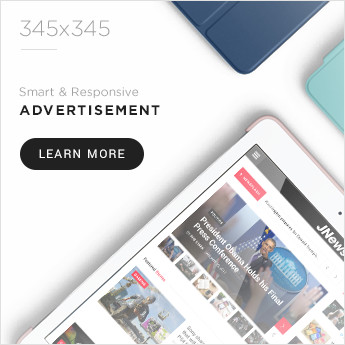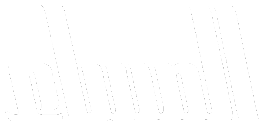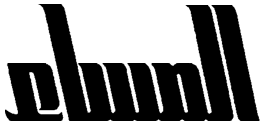بلد الأفيون.. اجتذبنى عنوان الكتاب، فأخذته من مكتبة أبي. كنت طفلاً، فلم أدرك تفاصيل الأشياء، لكن الحزن هو المعنى الكلي الذى داخلني وأنا أقرأ الكتاب الذي ترجمه عادل كامل وأحمد زكى مخلوف (الأديبان الكبيران فيما بعد ) يعرض لمأساة شعب قتله الأفيون!
ثم توالت الأعوام منذ صدور الكتاب في 1945، إلى أيامنا الحالية، وشهدت الصين تحولات مهمة، مثلت انقطاعًا بين ما كانت عليه، وما هي عليه الآن. شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حربًا أهلية بين القوات الحكومية بقيادة شين كاي تشك وقوات الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونج، وانتهت الحرب بهزيمة قوات كاي تشك، وفرار قائدها إلى جزيرة صينية هي تايبيه، حيث أقام دولة سماها الصين الوطنية.
مرت الصين منذ 1949 – سنة إعلان جمهورية الصين الشعبية – بتغيرات أملاها تصور ماو تسي تونج ورفاقه أن بلادهم ستظل زراعية، ومن ثم فقد تركزت رؤاه على الفلاحين، وليس على العمال كما في الاتحاد السوفييتي وبلدان شرق أوروبا. وكان تشكيل المزارع الجماعية في 1955 خطوة إلى الوراء، حيث انخفض الإنتاج في السنوات التالية إلى 40%، كما بلغ العجز في الغذاء مستويات قياسية.
قرر ماو أن يكون التصنيع هو الحل البديل، والحاسم، لإنقاذ الصين من التوقعات المؤلمة، لكن التفكير لم يقترن بالفعل، وحلت بالبلاد مجاعات مات بتأثيرها في الفترة من 1959 إلى 1962 ما يقرب من 40 مليون نسمة، وشهدت الصين أحداثًا مماثلة لما أورده المقريزي فى كتاباته عن التاريخ المصرى فى القرون الوسطى، فقد أكل الناس الحشرات والجيف، وأقدموا على جعل البشر طعامًا، وبادت – من شدة الجوع – قرى ومدن بأكملها.
الغريب أن تلك المجاعات لم تكن وليدة عجز في الإنتاج الزراعي، لكن ذلك ما فرضه سوء التوزيع، حين امتلأت مخازن الجيش بالغلال، وعملت الدولة على تصدير القمح، بينما المجاعة تفتك بالملايين من الفقراء.
بعد رحيل ماو تولى هيساو دنج قيادة البلاد، وكانت تلك فرصة طال انتظاره لها طيلة العهد الماوي، حتى أنه دخل السجن، وعزل من وظيفته، ونقل إلى وظيفة صغيرة ، لكنه لم يفقد الأمل فى الصين الحديثة.
تقول نكتة هندية إن دنج كان مشغولًا بقراءة صحيفة في سيارته.
سأله السائق: إلى اليمين أم إلى اليسار؟
قال دنج: لا مشكلة. أشر إلى اليسار، واتجه إلى اليمين.
والمعنى مجازي، يشي بأن ما أعده الرجل يختلف تمامًا عن السياسة الاقتصادية الصينية كما خلفها منشئ الصين الحديثة ماو تسي تونج.
استطاع دنج – بالإفادة من خبرات وطنية – أن يجري تبديلًا على هيكلية الاقتصاد، وزاد دخل الفلاحين ما بين 1978 و 1984، بنسبة 15%، وإن ظل الفقر مسيطرًا بصورة عامة.
وكانت الخطوة الحاسمة لعملية التحول الاقتصادي، حين بدأت الصين – فى 1978ـ في ربط اقتصادها بالاقتصاد العالمي. وتنقل دنج بين العديد من الدول الآسيوية للتعرف إلى تجاربها، وتبع زياراته إيفاد المئات من الكوادر الصينية لدراسة صورة الصين بعد التحديث.
شجعت الدولة الشركات الأجنبية على استثمار أموالها فى البلاد، واجتذبت – بالفعل – أكثر من 600 مليار دولار لصالح المشروعات الصينية، وهو مبلغ يتضاءل أمامه – كما يقول الخبراء – كل المبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة على مشروع مارشال الذي استهدفت به واشنطن مساعدة أوروبا على مجاوزة أوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما أفادت الصين من وفرة الأيدي العاملة في استحداث حركة تصنيع هائلة. قوامها الرصيد البشري الضخم، المتمثل في الملايين من الأيدي العاملة الرخيصة، بما يعوض تكلفة التكنولوجيا الباهظة في البداية، ثم – فيما بعد – بالاعتماد على الأيدي العاملة المدربة على أحدث التقنيات، لتصبح الصين ثاني أكبر دولة اقتصاديًا، بعد الولايات المتحدة، وتخلف اليابان وراءها.
تقول روبين ميرديث فى كتابها ” الفيل والتنين “، بترجمة ممتازة لشوقى جلال: ” لقد كانت الثورة الاقتصادية ثورة صامتة، صرخة داخل قاعة مانعة للصوت، تصاعد الرخاء لشعب تعداده أكثر من مليار، وجاء عصر شهد، تدريجيًا وإداريًا – والقول لروبين ميريديث – أكبر انتعاش عرفه كوكب الأرض لمشروعات الأعمال.
بالأرقام، فقد كانت الصين في سنة 2000 تصدر 20% من لعب الأطفال في العالم، وقفزت النسبة إلى 75% بعد خمس سنوات، وفي صناعة الأحذية تنتج الصين الآن زوجًا من بين كل ثلاثة أزواج أحذية تنتجها مصانع العالم. وقد لاحظت شخصيًا أن صادرات الصين من الأحذية فى أسواق القاهرة تتجه إلى كل مستويات الدخول. ثمة حذاء لا يجاوز ثمنه آحاد الأرقام، وحذاء آخر يبلغ المئات!
لا أحد الآن، لا أحد، ولو من حيث انخفاض السعر، يقوى على منافسة صادرات الصين في صناعة الاتصالات والأجهزة الكهربائية والسيارات والدراجات البخارية والملابس وأدوات الزينة.. كل شيء تقريبًا. وجملة ما تصدره الصين الآن في يوم واحد يفوق ما كانت تصدره في عام كامل، قبل عام 1978، عندما بدأت الصين انفتاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، وليس انفتاح السداح مداح الذي عانت مصر ويلاته على مدى سنوات طويلة.
تجاوز غالبية أبناء الصين خط الفقر، وذاقت قطاعات كثيرة طعم الثراء، وعرفت الأرقام المليونية،
بل والمليارية، أرصدة كبار الاقتصاديين الصينيين. ونشأت طبقة جديدة قوامها أكثر من 320 ألف مليونير، تتركز أنشطتهم في صناعة السيارات والسلع الترفيهية.
ولا يخلو من دلالة قول أحد المسئولين الصينيين: ” إن شباب الجامعات في بكين يعرفون أن مرتباً قدره 15 ألف دولار فى السنة، فى الصين، يتجاوز من حيث قيمته راتبًا قدره 45 ألف دولار في الولايات المتحدة. إنهم لا يريدون الآن الانتقال إلى الولايات المتحدة، أو إلى أي مكان آخر، لأنهم الآن يملكون فرصًا كثيرة داخل الصين” .
ظني أن ذلك هو ما سيكون تصرف الشباب المصري إذا صارت بلاده في الصورة التي يريدها.
بلغ انتشار الاقتصاد الصينى حد النكتة، مئات النكات تتناول باعة المنتجات الصينية في الوطن العربي، وربما فى أنحاء العالم. وبالطبع فإن تلك النكات نابعة من الوجود اللافت لأبناء الصين في المجتمع المصري. غالبية الصادرات منتجات صينية، حتى السلع البسيطة والتافهة، لا يكتفي الباعة الصينيون بحمل البضائع على ظهورهم، وطرق أبواب البيوت، إنما وسعوا من أنشطتهم إلى حد احتراف الحلاقة، وإجراء عمليات الختان، والزواج من شبان مصريين يعانون ظروفًا اقتصادية.. والأرقام تتحدث عن مائة ألف بائع صيني فى القاهرة وحدها، بالإضافة إلى آلاف اخترقوا عمق الريف المصري، في الوجه البحرى والصعيد، باعوا سلعهم، وأقاموا علاقات، وصاروا – على نحو ما – جزءًا من البيئة.
يضيف إلى سلبية الصورة أن بعض المستوردين المصريين يحرصون على المستويات الأدنى من البضائع الصينية، أو الفرز المتأخر بلغة التجارة، تجد تلك البضائع رواجاً هائلاً في السوق المصرية، انطلاقًا من انخفاض أسعارها ـ بصرف النظر عن رداءة المستوى – قياسًا إلى الصناعات المصرية. وبلغ الأمر حد استئجار مجموعات من الصينيين شققًا في الضواحي – جعلوها فى الخفاء – مصانع للملابس الجاهزة، تحمل عبارة ” صنع في الصين”.
امتدت محاولات الصينيين لتقليد الحرف اليدوية المصرية بصنع آثار مقلدة زهيدة الثمن. الصناعات المصرية كالحفر على الخشب، والأرابيسك، وتطعيم الخشب بالصدف، تتميز بأنها من صنع أيدي مدربة، وتتقن عملها، وتقدمها باعتبارها فنًا عربيًا. أما الصناعات الصينية فتقتصر على التقليد بواسطة الآلة التي تخلو من حرفية الصانع الماهر. حتى الذهب صار مقلدًا. وأكدت تحليلات أن البضائع الصينية تهدد بانقراض صناعات خان الخليلي فى مصر، لأنها تحسن تقليدها، وإن ظلت منحفضة الجودة، وتصدرها بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار المنتجات المصرية. وللأسف فإن الكثير من محال خان الخليلي تكتفي بعرض المنتجات المصرية المقلدة الواردة من الصين.
الطريف أن وكالة الأنباء الصينية الرسمية أجرت تحقيقًا توجهت به إلى مواطنين مصريين، يسأل: كيف تصبح حياة أسرتك في حالة عدم وجود البضائع الصينية في مصر؟
بالطبع، فإن اللجوء إلى الوسائل التي يتبعها مصدرون صينيون خطأ لا أتصور أن الصناعة المصرية تقدم عليه.
نحن مطالبون بأن نأخذ عن التجربة الاقتصادية الصينية إيجابياتها، وأن نهمل – فى المقابل – ما أفرزته من سلبيات، ولدينا العقليات العلمية، والأيدي العاملة المدربة، والموارد الطبيعية، والبيئة الصالحة.
تأمل التجربة الصينية يفرض الأمل في أن تكون إيجابيات ما حدث هي صورة مصر المستقبل.