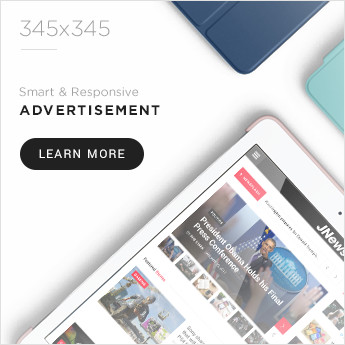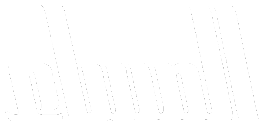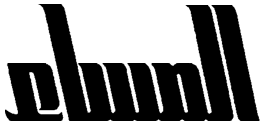عندما سئل أستاذنا نجيب محفوظ عن بواعث تأخره في الزواج ، قال : كنت أخشى أن يعطّلني الزواج عن الأدب!.
وإذا كان زواج الأديب قرارًا يحتاج إلى التأمل والتدبر، فإن الباعث – في تقديري- هو الخشية من تبعات المسؤولية، من السؤال والمحاسبة والإصرار على مقاسمة الوقت بين الأدب والبيت.
لعل المشاعر الفياضة التي تسيطر على نفوس المبدعين وتصرفاتهم، هي التي أملت على البعض طلب الزواج من نساء صادفهن في حياته.
ثمة زوجات يتفهمن معنى كلمة ” أديب “، والمكانة العامة التي تتحقق له، بما قد يشغله، أو يجعله – وهذا أخطر – موضعأ لإعجاب البعض من الجنسين.. لكن غيوم الغيرة تتبدد أمام شمس الثقة والحب والتعاطف والفهم، ونتذكر المثل القديم: وراء كل عظيم امرأة!.
الأمثلة كثيرة، تحقق الزواج في بعضها، وواجه الطلب رفضًا حاسمًا في بعضها الآخر، وإن ظل الفشل عنوانًا في معظم الأحوال.
يروي توفيق الحكيم في سجن العمر عن أبيه الذى كان محبًا للثقافة والإبداع، ودخل بالفعل في نقاشات فلسفية ومداعبات شعرية مع لطفي السيد، لكنه تنازل عن اهتمامه بالكتابة الأدبية، امتثالًا للفرمان الذي أصدرته زوجته – كم أجاد الحكيم تصوير شخصيتها المتسلطة في “عودة الروح” و”سجن العمر” – بوضع صناديق كتب زوجها حيث تضع الكراكيب ، وزادت فدعته إلى قصر اهتماماته على ” مشاغل العيش والكفاح من أجل تدبير موارد في الأرض والأطيان والسماسرة، والبيت الذي اشتراه والبنك والأقساط والرهنية والفوائد المستحقة”.. وما بين مزدوجتين من كلمات الحكيم!
سأذكر لك مثلًا ثانيًا:حين التحق صديقي د . ط مجاورًا في كلية اللغة العربية بالأزهر ، كان ” التحقق ” في الحياة الأدبية هو ما يشغله. وجد في كتاباته القصصية ما يؤهله للحصول على موضع – لم يحدده ! – في الحياة الأدبية. كان أبوه قد زوجه قبل أن يبلغ السابعة عشرة. ترك زوجه والطفلتين، وقدم من مدينته الجنوبية إلى القاهرة. فضل أن يستأجر حجرة فوق سطح بيت بالقرب من الأزهر، فلا يعاني في الذهاب إلى الكلية. ظل وقته موزعًا بين المذاكرة والكتابة الأدبية، فضلًا عن التردد على دور الصحف والناشرين لنشر إبداعاته، ولزيادة دخله بالعمل مصححًا بالقطعة. ثم التقى القمر في صعوده – ذات ظهر – على سلم البيت، سلبه نظراته ووجدانه، وأربكه. عرف أنها تقطن في شقة الطابق الثاني. حرص على تكرار الصعود والنزول، يلقي التحية بصوت هامس، وعيناه تتجهان إلى الناحية المقابلة، وقدماه تتعثران في السلم الأسمنتي، ويلتقط نظرة فاهمة، تومئ بالتحريض في مرات تالية، ويختصر بيت شوقي الشهير فيتقدم لخطبتها. تشترط عليه العروس أن ينسى القرية وكل من فيها وما فيها، وأن يخضع جهده للتصحيح الذي يدر نقودًا، ويهمل الأدب الذي يضيع الجهد. قل إبداع صديقي، وإن ظل متميزًا. كان يختلس اللحظات ليقرأ ويكتب، وتباعدت رسائله – وتحويلاته المادية – إلى القرية. كان الأب والأم والزوجة والبنتان يعيشون من المبالغ القليلة التي كان يبعث بها. ولما تأزمت أحوالهم المادية، تسول الأب قيمة التذكرة، وسأل عن البيت الذي كان قد انتقل إليه – بعد أن تبدلت حياته – في مصر الجديدة. جاء صديقي، فوجد أباه يجالس البواب. أفزعه الثوب المتهرئ والقدمان الحافيتان. أخذه من يده إلى ميدان الجامع، اشترى له حذاء، ودس في يده مبلغًا بسيطًا، وظل في وقفته على رصيف عربة الدرجة الثالثة بالقطار، حتى غاب القطار في الأفق .
روى لي أديب من مدينة صديقي، أنه شاهد أمه وهي تقف على سكة القطار تناديه بالقول: إذا التقيت فلاناً فالتهمه!
كانت الدروس الخصوصية قد رقت بحياة صديقى، فانتمى إلى الطبقة الوسطى، واكتفى – فى المقابل – بدفع قيمة أردبى ذرة لابنتيه، ينفقان منها طيلة عام!
نشر صديقي في الصحف ما يشكل مجموعة قصصية، تقدم بها إلى هيئة الكتاب. تعددت زياراته إلى مبنى الهيئة في رملة بولاق، يسأل عن مجموعته. استفزته الردود المماطلة والمقتضبة، فعلا صوته بالشكوى – ذات عصر – من التفرقة في المعاملة بين الأدباء، من يستندون إلى مكانتهم يؤشر رئيس الهيئة على أعمالهم بالقلم الأحمر، من يريد أن يحصل على دوره أشر على عمله بالقلم الأزرق. أما من يرفض عمله – دون إعلان – فهو يوافق بالقلم الأسود. لم يفطن صديقي إلى اختلاف التوقيعات، حتى نبهه زميل صحفي وقع رئيس الهيئة على كتابه بالقلم الأحمر، فبدأت خطوات طباعته.
علا صوت صديقي بالاحتجاج . وفتح الرئيس الأسبق للهيئة باب مكتبه: ماذا حدث؟
– له كتاب تأخر صدوره.
قال رئيس الهيئة :
– لسنا ملزمين بنشره!
تكلم صديقي عن ضرورة ألا تحابي الهيئة أديبًا على آخر، هي مؤسسة عامة يجب أن تساوي بين المتعاملين معها.
قال رئيس الهيئة بنبرة غاضبة:هؤلاء أدباء.
وأشار ناحية الباب الخارجى:خذوه!
وحسب رواية صديقي، فقد وجد نفسه محمولًا على أيدي موظفين، عبروا به الطريق إلى الرصيف المقابل، وتركوه!
قاطع صديقي- من يومها – كل ماله علاقة بالأدب والأدباء. اكتفى بالدروس الخصوصية، بتحريض من الفاضلة زوجته. لم يعد يقرأ ، حتى ما ليس من المناهج الدراسية.
كنت ألتقيه أحيانًا. أسأله عن أحدث كتاباته.
يجيب في سرعة:لا شيء!.. أنتم أدباء تكتبون فتنشرون، أما أنا فلست أديبًا!
مما أتذكره كذلك صديق أديب، كانت الفاضلة زوجته تحرص، بين فترة قصيرة وأخرى، على الوقوف أمام مكتبته متأملة، ثم تصدر مرسومًا زوجيًا باترًا:هذه المكتبة يجب أن تخفض إلى النصف!.
يحاول الزوج المسكين أن يوضح الأمر، وأنه يعد لدراسة تحتاج إلى كل تلك الكتب التي اشتراها من حر ماله، لكن الزوجة تهز رأسها في رفض حاسم، وتكرر إعلان المرسوم الزوجي!..يضطر صاحبنا إلى الاتصال بأصدقائه الأدباء، يعرض عليهم أجمل هدايا حياتهم: أن يستضيفوا مجموعات من كتبه، بوعد أن تعاد إذا احتاج إليها!
مثلًا آخر: صديق شاعر عانى الغربة لسنوات، في بلاد الله خلق الله، حتى يوفر لعياله العيشة الهانئة. وحين أدرك أنه قد أدى ماعليه نحو أسرته، قرر الإقامة في القاهرة بدءًا لرحلة تحقيق الذات الشاعرة، وصدر له بالفعل ثلاثة دواوين.
عرضت عليه زوجته أن يقترب – ماأمكن – من إيراده السابق، عندما كان مغتربًا ينشد الرزق الأوسع، وصارحها الزوج بأنه خلاص قد تعب، فلم يعد يقوى إلاّ على عمله الوظيفي كمدرس. أما وقت فراغه، فقد قرر إنفاقه – بحول الله – في كتابة القصائد.
عرضت الزوجة – كحل وسط – أن يعطي دروسًا خصوصية، لكنه رفض بإباء: أنا شاعر.. وسأنفق كل فراغ وقتي فى كتابة الشعر!
خرج الزوج إلى مدرسته،فجمعت الزوجة أطفالهما، وقدمت لهم طبقًا مملوءًا باللحم الشهي.
بعد أن انتهى الأطفال من الطعام، سألت الزوجة: مارأيكم؟
قالوا: جميل!
قالت: هل تريدون أكل اللحم كل يوم؟
قالوا: ياريت!..
قالت: إذن، اطلبوا من أبيكم أن يعطي دروسًا خصوصية!
جاء الزوج من مدرسته. وبمجرد أن فتح له الأطفال الباب، صاحوا في صوت واحد: نريد أن تعطي دروسًا خصوصية!
مثلًا ثالثًا: بطله أديب من جيل الستينيات، كنا نأمل أن تكون إبداعاته أبرز معطيات جيله .. لكن الزوجة الحسناء كانت تغير عليه من كل شئ، حتى من أصدقائه وكتبه وكتاباته، تريد أن يظل بالقرب منها، يبثها لواعج حبه، فلا ينصرف إلى شئ آخر.
ظل صديقنا الواعد يبتعد ويبتعد، حتى اختفى من حياة أصدقائه، ومن الحياة الأدبية كلها. أحيانًا، أمر بسيارتي أمام بيته، أراه جالسًا في الشرفة إلى جانب الزوجة الغالية، يتسامران، ويقزقزان اللب، فأدرك أن صديقنا الأديب قد اختار الاستقرار الأسرى، ولم يعد يشغله الإبداع بتوتراته وهمومه!