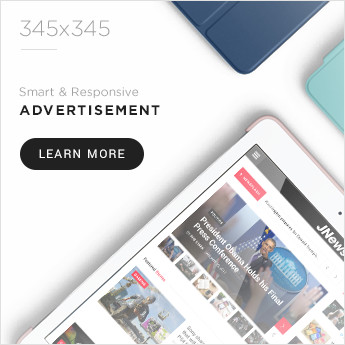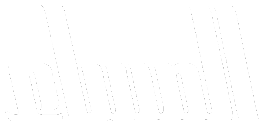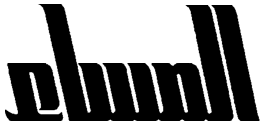لعلك تابعت مباريات كرة القدم التي لعبها فريق المكابي الإسرائيلي في أمستردام، وإقدام مشجعي الفريق الإسرائيلي على إنزال الأعلام الفلسطينية من واجهات البيوت، وتحطيم اللافتات، وترديد شعار ملخصه أن المدارس الفلسطينية بلا تلاميذ لأن التلاميذ قتلوا!
كان رد الفعل بديهيًا من المواطنين ذوي الأصل العربي، ومناصريهم من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، وعانى البلطجية الصهاينة ما دفع نتنياهو إلى إعادتهم إلى فلسطين المحتلة بواسطة طائرتين، وأعاد ترديد اتهامه السخيف، والممل، بعداء السامية!
وإذا كانت السلطات الفرنسية قد منعت صدامًا متوقعًا بين مشجعي الفريق الوطني الفرنسي وفريق إسرائيل، فإن المدرجات الخالية، والهتافات المنددة بالعدوان على غزة ولبنان، كانت مؤشرًا يصعب إغفاله.
تحفظى معلن على حكايات الهولوكست النازية والمحارق والأفران ومعاداة السامية، وكل تلك الدعاوى الصهيونية التي اعترف الكثير من الساسة والمفكرين اليهود أنها ليست سوى وسائل ابتزاز ضد كل من يرفض الممارسات الصهيونية.
لماذا اليهود ؟
لماذا ليس المنتمين إلى عرقيات وجنسيات أخرى، بمن فيهم الألمان؟ ولماذا ليس الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وأبناء دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وعمال أبو زعبل وأطفال بحر البقر الذين مارس الكيان الصهيونى ضدهم أبشع الممارسات؟
اعتدنا في تاريخ الممارسات الإسرائيلية أنها تطلب تصديق الآخرين لما اختلقته، يساعدها إعلام إيديولوجي يحذف، ويضيف، ويضفي الرتوش، وربما بدل الملامح. فإذا طرحت الرواية الصحيحة قوبلت بالتعتيم، أو بالرفض، أو التشويه.
ذلك ما نلحظه حتى في تضاد الروايات، فإسرائيل الجزيرة المسالمة المحاطة ببحر من العداء، هي إسرائيل صاحبة اليد الطولى التي قتلت قادة فلسطينيين في بيروت وتونس وعواصم عربية وأوروبية أخرى، وهي التي تجهر أن القتل جزء من ممارساتها. تساندها واشنطن – وعواصم الغرب – بصورة مطلقة، إلى حد تبديل الولايات المتحدة مقترحاتها على امتداد ما يزيد عن العام، تلبية لمطالب نتنياهو الذى أجمع حتى قادة المعارضة الإسرائيلية أنه يدير كل شيئ بهدف الإفلات من المثول أمام القضاء.
على الرغم من سامية العرب، فإن تهمة المعاداة للسامية لم توجه إلى إلى كل مظاهر العداء لهم، وما أكثرها. السامية – حتى فى حال معاداتها – تقتصر على اليهود وحدهم. كان مفهوم العداء للسامية يشمل كل من العرب واليهود – تاريخيًا – فى القرن الثامن عشر.مع ذلك، فإن دعاوى إسرائيل ترتكزـ على أنها جزيرة في محيط من العداء، يتحدد فى العداء للسامية.
نحن ساميون، هذه حقيقة تاريخية وعرقية، لكن الميديا الصهيونية التى أفقدتنا حتى الثقة بأنفسنا، أفلحت في إقناعنا بأن السامية جنس يقتصر على اليهود!
كانت معاداة السامية أحد مخترعات قادة الصهيونية لبذر الإحساس بالاضطهاد عند اليهود، مقابلًا لبذر الإحساس بظلم اليهود عند أبناء الأجناس الأخرى. وكان تقديم هرتزل أن معاداة السامية ستكون هي القوة الدافعة الأهم التي ستعين الحركة الصهيونية على بلوغ أهدافها.
المؤسف أن اليهود أفلحوا في جر بعض المؤرخين والساسة العرب لدرء الاتهام بأنهم معادون للسامية، وهو اتهام من المستحيل – موضوعيًا – أن يوجه إلى عربى، لأن العرب ساميون!
التوراة تذهب إلى أن العرب هم أبناء النبى إسماعيل، وهو والنبي إسحاق ابنا إبراهيم الخليل، فأولاد إسماعيل وإسحاق إذن أبناء عمومة، وبمعنى آخر فإنهما ينتميان إلى السامية.
العرب الأصليين هم ساميون من قبيلة سام، ولفظ عربى هو التعبير السامى عن ساكن الصحراء، وفي الهجرة العربية الأولى عام 3500 ق . م التي غادرت شبه جزيرة العرب إلى مصر، مرورًا بالحجاز وسيناء، اختلط الساميون بالحاميين، فجاء المصريون الذين أفرزوا ثقافة مغايرة يمكن تسميتها ثقافة النهر، أو الثقافة النهرية، ارتكازًا إلى الطبيعة المصرية، التى يعد النهر والزراعة والوادى والصحراء المنبسطة من أهم أبعادها.
مع أن العرب ساميون، فإن الإعلام الصهيونى قصر السامية على اليهود، كل من يهاجم اليهود هو عدو للسامية. الأغرب أنهم وجهوا الاتهام نفسه إلى العرب. واتساقاً مع ميل الشخصية العربية إلى الاعتذارية، فإنها تدافع عن نفسها ضد الاتهام الصهيوني، وأنها ليست ضد السامية!
تحت شعار معاداة السامية يندرج كل ما من شأنه معارضة الآراء والتصرفات والدعاوى الصهيونية. أنت تختلف مع الصهيونية في تلك النقطة أو تلك فأنت معاد للسامية!
الغريب أن ذلك الارتباك، أو الصمت العربى – الذى لا يمكن أن يتسم بالحكمة – يقابله تنبه وآراء رافضة لساسة غربيين. أذكر قول سياسي كندى بارز، وهو يتحدث عن الاتهام المعد سلفًا ضد كل من يدين الصهيونية: ليس معنى حديث المرء عن السلام أنه معاد للسامية. بل إن الصمت عن مناصرة الحق، والخوف من ذلك الاتهام الغريب، هو خطأ من الصامتين خوفًا، يبلغ حد الخطيئة!
ردد قادة الكيان الصهيونى اتهامهم كثيرًا، وجهوه إلى كل من ناقش أى تصرف لكيانهم، بأنه ضد السامية، الاتهام ينسحب على كل رأى، حتى لو لم يكن له صلة بالسياسة. أخذ الاتهام صفة التعميم، فهو يوجه إلى كل من يبدي ملاحظة ضد أي تصرف صهيوني.
لعلنا نجد التعميم نفسه في أكذوبة المحرقة. الصهيونية المسيحية في واشنطن تستصدر قرارًا من الأمم المتحدة – هو القرار الوحيد من نوعه فى التاريخ – يعتبر من يتشكك في المحرقة مدانًا، وعليه أن يواجه السجن. قد ينكر المرء وجود الإله، ووجود الأديان، وقد يكون ملحدًا. هذا رأيه، لكن ليس من حقه أن ينكر المحرقة.
هنا لابد أن يعاقب!
تذهلني المجتمعات الأوروبية التي تجد فى الإلحاد تعبيرًا عن حرية الرأى، وعن الديمقراطية التي تؤمن بالرأي والرأي الآخر.. لكن الديمقراطية الغربية ما تلبث أن تغيب، حين يتشكك دارس أكاديمي في حقيقة المحرقة النازية لليهود الألمان.
أعلن العالم البريطاني ديفيد إرفينج ـ-على سبيل المثال – اجتهادًا علميًا، استند فيه إلى وثائق وإحصاءات وبيانات، لكن الدنيا قامت ولم تقعد، واعتبر العالم البريطاني معاديًا للسامية، وقدم إلى المحاكمة في النمسا. وكما قيل، فإنه لو ظل على رأيه في دعوى المحرقة، ودلل بما في حوزته من وثائق، فسيواجه العقاب الذي قد يبلغ السجن 20 عاماً !
سبق المتظاهرون اليهود محاكمة الرجل حين استقبلوه بالحجارة والأوساخ وهو في طريقه إلى مكان التحقيق، فالإدانة إذن مسبقة، والعقاب مؤكد.
من قبل، واجه الموقف نفسه الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي ، ودفع غرامة هائلة لقاء تأليف كتابه” الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية”. كما واجه المأزق نفسه الكاتب الأمريكى نورمان جي فنلكستين الذي ألف كتابًا عنوانه ” صناعة المحرقة”.
اللافت أن الاتهام بمعاداة السامية يتجاوز إنكار المحرقة إلى معاداة اليهود، سواء بصرف النظر عن تعرضهم للمحرقة أم لا. أن يكون لك رأي فى اليهود كبشر، كتصرفات، كمزاعم، كدعاوى باطلة، فأنت تعادى السامية حتى لو كنت عربيًا أصوله سامية!
السامية التى تتحدث عنها إسرائيل، تكريس للدعوى الساذجة بشعب الله المختار، وهى دعوى أثق أنها ستواجه المصير نفسه الذي واجهته النازية، حين ادعت نقاء الجنس الآري، وعملت على سيادته لعالم ما قبل الحرب العالمية الثانية .