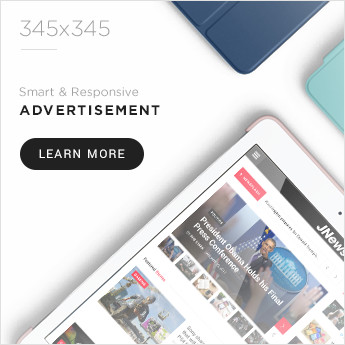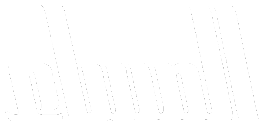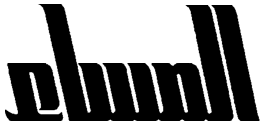قررت منظمة اليونسكو رفع بعض المواقع الأثرية المصرية من قائمة التراث الإنسانى العالمى. السبب – كما أذاعت وكالات الأنباء – ما جرى لهذه الآثار من إهمال وتشويه إلى حد صبغ هرم زوسر باللون البمبى!
خطورة تشويه الآثار، أو سرقتها، أو تدميرها، أنها تعنى الضياع أو الاندثار، حيث لا سبيل إلى استعادتها. حتى الترميم الذى يحاول إصلاح ما أفسده المخربون لا يعيد الأثر إلى أصله.. والشواهد كثيرة.
كل شيء يمرض، بداية من البشر، وانتهاء بالحجر، قد يبرأ بالعلاج.. أما العدم فإن إكرام الميت – كما يقول المثل – دفنه، وهو المثل الذى لجأ إليه الرئيس السادات حين أراد تبرير ما لحق بتمثال توت عنخ آمون من أذى مدمر فى رحلته إلى الخارج.
ما لا يقدر بثمن، ويصعب استعادته، يتجاوز معنى السرقة أو التدمير، حتى الذى يسطو على قطعة أرض امتلكها، أستطيع أن أستعيدها بوسيلة ما، ومنها اللجوء إلى القوة. أما جريمة الآثار فإنه من الصعب – إن لم يكن من المستحيل – تعويضها.
جرائم الآثار هى قضية أمن قومى، ليست مجرد حوادث عادية، لكنها اعتداء على التراث، الذى لا تستقيم بدونه حضارة أية أمة. لذلك كان حرص الغرب بتاريخه الذى لا يزيد عن بضع مئات من السنين، على إلباس ثوب التراث ما ينتمى إلى عقود قريبة، مجرد أن ينسب إلى نفسه حضارة لم تكن موجودة. ولعلنا نلحظ حرص إسرائيل الغريب أن تدعى لها تراثاً، حضارة، حتى لو جاء ذلك على حساب التراث الفلسطينى بخاصة، والتراث العربى بعامة.
زمان، سرقت المسلات المصرية، وسرق رأس نفرتيتى، وكنوز توت عنخ آمون، وآلاف القطع الأثرية التى تنتمى إلى التاريخ المصرى فى عصوره المختلفة، وقد ارتدى موشى ديان – عقب نكسة 1967 – قناع عالم الآثار، وأشرف بنفسه على نهب مئات، وربما آلاف القطع الأثرية من سيناء. وكما نعلم فإن الآثار المصرية تشغل أجنحة كاملة، فى باريس ولندن وواشنطن وغيرها من عواصم العالم، والمخطوطات والوثائق النادرة موزعة فى مكتبات لشبونة واستانبول ومدريد وموسكو وغيرها.
هذا النزف الذى تعرض له تراثنا الوطنى فى امتداد التاريخ ، ومن خلال عمليات النهب والتشويه التى مارسها لصوص ومغامرون وعلماء آثار، غاب – بتبدده – فى أفق المستحيل. ولن يتحقق الحفاظ على ما تبقى إلا باعتبار سرقة التراث – بصرف النظر عن قيمته – جريمة تستحق المؤاخذة الرادعة.
الأخبار التى تطالعنا بروتينية سخيفة عن اكتشاف تشويه قطع أثرية أو مخطوطات، أو ضياعها، ومعاقبة هذا المسئول أو ذاك، لا تلغى حقيقة أن هذا التراث فقدناه بالفعل.
أغلب الظن أن ما شوه، أو دمر، ذهب لن يعود، وبالإضافة إلى التعامل الجاد، والمسئول إزاء ما فقد، وبذل كل الجهود لاستعادته، فلا أقل من الحرص الجاد على أعز ما تملكه أمة، وهو تاريخها، وتراثها الوطنى .
عندما نلح على قضية سرقة الآثار، فلأن سرقة الأثر تعنى ضياعه، وضياع الأثر يعنى – بلا أدنى مبالغة – اقتطاع جزء من التاريخ المصرى، أو الذاكرة المصرية.
طالعتنا وسائل الإعلام – فى الأيام الماضية – بجرائم سرقة وتهريب للآثار، بلغت حد استخدام سلم، والصعود عليه داخل جسم الهرم الأكبر، والطيران إلى ألمانيا بما تمت سرقته، بلا حس ولا خبر، اللهم إلا بعد أن أذاعت التقارير الإعلامية ما حدث!
لا عذر بقلة الحراس، ولا ضعف الإمكانات، وحين تنشأ وزارة للآثار فإن المعنى الأبسط لوجودها أنها تحمى أثارنا، وترممها، وتدراْ عنها محاولات السطو والسرقة. ما حدث فى الفترة الأخيرة يشير باهتزاز قبضات الأيدى إلى السادة المسئولين عن الآثار المصرية، بداية من الوزير، حتى الخفراء الذين قد تغيب عن وعيهم أهمية المواقع التى يحرسونها!
تصورت أن كل المسئولين فى بلادنا، ستحركهم الغيرة الوطنية بعد أن قررت منظمة اليونسكو رفع بعض المواقع الأثرية المصرية من قائمة التراث الإنسانى العالمى، لما جرى لهذه الآثار من إهمال وتشويه بلغ حد اقتحام حرم خوفو، وصبغ هرم زوسر باللون البمبى، وسرقة هرم سقارة بواسطة بعض المسئولين عن حراسته!
أذكر أنى تناولت خطورة تشويه الآثار، أو سرقتها، أو تدميرها، وأنها تعنى الضياع والاندثار، حيث لا سبيل إلى استعادتها. حتى الترميم الذى يحاول إصلاح ما أفسده المخربون لا يعيد الأثر إلى أصله.. والشواهد كثيرة.