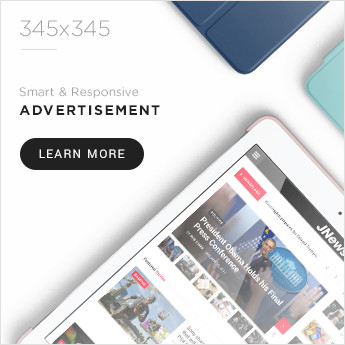كنت أظن أني كتبت عن الإسكندرية، حي بحري خاصة، في كتاباتي السردية. أضافت إلى ظني آراء نقدية وقرائية وجدت في حوالي ثلاثين رواية والكثير من القصص القصيرة مشهدًا بانورميًا للحي الذي التقت فيه راقودة بفاروس في مايسمى الآن بحري.
غادرت بحري في أواخر الخمسينيات، ثم عدت إليه في فترات متقاربة، ومتباعدة، أتنفس هواءه، وأمضي.
أتاحت الظروف لعباس حسين صداقة دائمة، متجددة، للمكان، حرص – من ناحيته – على هذه الصداقة.
السمة الأولى التي تطالعك في كتاب عباس حسين ” سكندريات” أن مؤلفه محب للإسكندرية، يشغله ماضيها، وتأمل حاضرها، ومحاولة استشراف مستقبلها. ما يراه، ويجذب انتباهه، يسجله مشفوعًا بملاحظات. ربما أعاده مشهد جديد إلى مشاهد سابقة، ينسى أنه كتب عنها، فيعيد الكتابة بصياغة مختلفة. ولعلي كنت أرجو أن يكلف الناشر محررًا بمراجعة النص، وإعداده للطباعة. لا يتدخل في السرد، بل يقسم النص إلى فصول، تصلها خيوط، سواء بالتلاحم المكاني، أو بالترتيب الأبجدي، بمعنى أن يلتزم منهجية تقرب المعنى من ذهن المتلقي.
أنت في كتاب عباس حسين تتنفس الإسكندرية، تخالط ناسها، تستعيد ماضيها، تعايش مشكلاتها الآنية. تجول في شواطئها وأسواقها وميادينها وشوارعها وحواريها ومقاهيها وأزقتها، تألف المقيمين وعابري السبيل.
سكندريات عباس حسين إضافة مهمة إلى موسوعة الجزايرلي. عني الجزايرلي بالزمكانية، صلة الأمكنة بالتاريخ القديم والحاضر وأهم الأحداث والشخصيات. أما عباس حسين فقد رسم التكوينات التي تمثل – بملامحها ومنمنماتها وألوانها وظلالها – تجسيدًا لحياة لها مقوماتها وتمايزها. لم يعد إلى المصادر والمراجع إلّا لاستكمال معلومات خاصمت الذاكرة، وإن جاءت حصيلة الكتاب ثمرة صداقة محبة لكل ما تضمها الإسكندرية بين الميناء الشرقي والميناء الغربي، وامتدادت الأحياء الجديدة.
طالعتني – في صفحات الكتاب – أسماء أعرفها، وأخرى داخلني الاعتزاز لانتمائها إلى الإسكندرية، وإلى بحري بخاصة: محمد كريم وسلامة حجازي وسيد درويش وبيرم التونسي ومحمود سعيد وحسين بيكار وعصت عبد المجيد والديبة وعبد اللطيف أبو هيف ومحمود فياض وعصمت داوستاشي وفاروق حسني وسعيد سالم وزينات صدقي ونعيمة الصغير وعادل أدهم ومحمد وفيق وأحمد المسيري وبدرية السيد وسمير صبري وصلاح الشرنوني وفاروق الشرنوبي وحمامة العطار والشيخ أمين والسيد حلال عليه وعشرات غيرهم.
ثمة أبواب شرق والكراستة والجديد والأخضر وعمر والجوامع والمساجد والزوايا والأضرحة والمقامات، بداية من المرسي أبو العباس، سلطان الإسكندرية، حتى ولي بلا اسم، فهو مقطوع نذره، وحلقة السمك ومعهد الأحياء المائية، وثمة الأسواق، ما اندثر منها، وما يصارع التلاشي: الحصر والخيط والصاغة والكانتو والنقلية والعقادين والترك والمغاربة، عالم يموج بالمشايخ والمعلمين والفتوات والأبو أحمدات والتجار والحرفيين والصيادين وباعة السمك والعوالم، والجاليات الأجنبية التي غادرت المدينة – ومصر كلها – عقب عدوان 1956. لكن ذاكرة الكاتب تستعيد الوجود الأجنبي في المدينة، الجاليات الإيطالية واليونانية والإرمنية، والمهن التي كانت تقتصر على أبناء كل جالية.
إذا كانت الأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية قد حققت توسعًا من خلال الزيادة السكانية، وهو ما نلحظه في المقاهي والمطاعم والمحال التجارية وغيرها، فإن الظاهرة الغريبة هي قلة عدد دور السينما بصورة لافتة. لا جديد، والدور القديمة تحولت إلى أبراج سكنية وجراجات: ماجستيك، بلازا، ركس، كونكورديا، الدورادو، التتويج، رأس التين، الأنفوشي، إلخ.
قبر الإسكندر يدعو إلى البحث عنه، واكتشافه. وهو ماحاوله بطل روايتي ” غواية الإسكندر” الأستاذ الجامعي وليد صبحي. تمنى عباس حسين أن يجد في القبر ما يعرفنا ببدايات المدينة، لكن الأستاذ الجامعي شغله البحث عن القبر لاحتوائه على طلسم يدرأ خطر الغرق عن الإسكندرية.
حفل الكتاب بشخصيات من قلب الحياة الشعبية السكندرية: عم حسب الله الكتبجي ( نسي عم حجازي ودوره الأهم في مكتبته بشارع الميدان ) عزيزة بلاميطة، ياقوت زنجر، حميدو الفارس، منصور أبو سنجر، السكران، الحاج على المستكاوي، لحاج رضوان الزنجبيلي، علي فلينة، أحمد باتشان، علي بلاموطي، الحاج محمد سليط ( كنت شخصيًا واحدًا من الآلاف الذين شيعوا جنازته ) علي مزيكا. كذلك فقد تضمن الكثير من الموروث الشعبي الذي ما زال يترك تأثيراته على سلوكيات الحياة اليومية، كزيارة الأولياء والاحتفال بذكرى ميلادهم والزار والعديد وفتح المندل وضرب الودع والتنجيم، والدراويش والمجاذيب في تناثرهم اللافت داخل ميدان الأئمة والشوارع المحيطة.
نحن نطوي الكتاب وفي ذاكرتنا كلمات للكاتب يخاطب بها المدينة التي يعشقها: ” لكل مدينة مفرداتها وأبجديتها التي تحل رموزها، وتكشف أسرارها، وتحكي تاريخها، إلًا أنت أيتها الغامضة، المفعمة باالألغاز، تختصرين تاريخك كله في غيومك الرمادية، عباءة من الغموض تطرحينها فوق البحر والمباني والطرقات، كتومة لا تبين ولا تفصح، فهي كوجه عذراء يطل – على استحياء – على الكون الفسسيح، وهي كتقاطيع رجل عجوز تنبيء بالحكمة وخبرات السنين:.
وإذا كان عباس حسين قد اعتبر كتابه جزءًا أول، سيتلوه جزء ثان، أو أجزاء تالية، فإن توقعي أن يعمق الكاتب رؤيتنا لأهم معلمين في الحياة السكندرية: بيئة البحر من خلال العاملين في الميناء والصيادين وباعة السمك، والبيئة الروحية التي تهب بحري ملمحًا استثنائية، بما يحويه من جوامع ومساجد ومزارات وموالد وإنشاد ديني وتسابيح وحلقات ذكر.
.