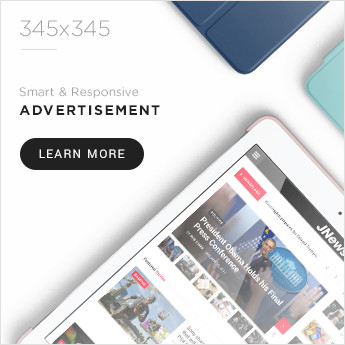المؤكد – تاريخيًا- أن الاحتفالات الدينية لم تكن قائمة فى حياة المصريين إلى القرن الرابع الهجري، حين غزاها الفاطميون، فوسموا الدين بطقوس واحتفالات ومواكب وأعياد، مثل الاحتفال برأس السنة الهجرية، وليلة المولد النبوي، وليلة أول رجب، وليلة المعراج، وليلة أول شعبان، وليلة نصف شعبان، وليلة رؤية رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وغيرها.
إذا كانت وقفة عيد الفطر تعني الوقوف لرؤية هلال رمضان، فإن وقفة عيد الأضحى تطلق على اليوم الذي يسبق أيام العيد، يوم الوقوف فى عرفات.
حين نطالع الأعمال الأدبية المصرية التي تنتسب إلى فترات تاريخية سابقة، في ضوء علم الاجتماع الأدبي، فستطالعنا صور مغايرة لما نراه في زماننا الحالي، لا طائرات ولا بواخر، ولا حج سريع، وغيرها من المسميات التي لم تكن تعرفها أجيال العصور القديمة، قبل أن يثمر التطور عن معطياته في مجالات النقل، كما هو الحال في بقية المجالات. فضلًا عن النقل التليفزيوني من الحرم المكي، الذي ينشغل فيه بعض الحجاج بتلويح أيديهم – عبر الشاشات – تحية لأعزائهم!
كانت الرحلة إلى الحج تختلف عنها فى زماننا الحالى. كانت رحلة شاقة للغاية، محفوفة بالمخاطر والأهوال [ أذكر فى قراءات طفولتي التي تنتمي إلى أربعينيات القرن العشرين، شكاوى الحجاج المصريين من هجمات البدو على قوافلهم للسرقة والسلب. وكانوا يشددون على وجوب حمايتهم بحراسات مسلحة ]
كان السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج على الجمال. وهو ما كان يفعله الكثيرون، بالخروج من مدنهم وقراهم بعد عيد الفطر بيومين، لتصل إلى الكعبة قبل العيد الكبير بأسبوع. وكان الإعداد لرحلة الحج يستغرق العام بأكمله. فإذا اقترب موعد السفر، ارتفعت أصوات النساء – فى القرى خاصة – بغناء يسمى ” التروية “، يغبط الحاج على قرب زيارته للديار المقدسة، ويدعو له بالسلامة فى الحل والترحال.
والعادة أن الصوفية يخرجون – قبل بدء سفر الحجاج – في مواكب مشهودة، تدق الطبول والدفوف، وتردد الأناشيد والأغنيات والترانيم والقصائد التي تتغنى بوصف الكعبة والحرم النبوي والبقاع المقدسة عمومًا. تسمية ذلك هي ” التحنين ” لأنه يعرض لما في النفوس من حنين إلى الحج والزيارة.
ويعلن الحاج العائد من الأراضي الحجازية اعتزازه بأنه صلى فى الحرم النبوي، ولمس شباك قبر الرسول. كما يحضر معه صفائح مغلقة ومبرشمة تحوي ماء زمزم. ولأن تكاليف السفر لم تكن بلغت الأرقام الفلكية التى تصدمنا الآن، فقد كان الحج سبع مرات أمنية غالية عند الكثيرين، بصرف النظر عن مستوياتهم الاجتماعية.
فى صباح عيد الأضحى – والوصف ليحيى حقي في رائعته القصيرة ” الدودة والإنسان” – يتجول الجزارون فى الشوارع، يحملون السكاكين، والنداء يسبقهم: جزار، أو: جزار نظيف، أو جلدة للبيع، فروة للبيع. وفروة الخروف – أحيانًا – هي المقابل الذي يتقاضاه الجزار، بالإضافة – طبعًا – إلى المقابل المادي. وعقب ذبح الضحية، يبدأ سباق إلى شىّ اللحوم والتهامها، فضلًا عن توزيع الصدقات على بعض الفقراء كالكناس وصبي الفران وغيرهما.
عادة، فإن الميسورين كانوا يضحون-ـ في كل عيد – بكبش أو أكثر، يأكلون منه، ويوزعون معظمه على الفقراء ( قلصت الظروف هذه الصورة، فلم تعد ثابتة ). وربما أوعزت الأريحية باستبدال الكبش ببقرة، توسيعًا على الناس.
لذلك فإن مائدة عيد الأضحى تحفل بالمشوى والمسلوق والمحمر والكفتة والكستليتة والممبار والموزة. واستحقت تسمية ” عيد المرق”.
قبيل العيد، وفي أيامه الأولى، تمتلئ محطات القطارات والأوتوبيسات ومواقف عربات الأجرة بالموظفين والعمال والطلبة الغرباء عن العاصمة، فى طريقهم إلى قضاء الإجازة مع ذويهم في مدن الصعيد والوجه البحري وقراه. وفى ليلة العيد تفتح أبواب السماء، وتستجاب فيها الدعوات.
حين شددت أم أحمد عاكف – في رواية نجيب محفوظ ” خان الخليلي” – على ابنها الأكبر ألاّ ينسى العيدية، عيديتها، فقد كانت تحقق الاستمرارية لتقليد مصرى قديم، يعود إلى مئات السنين فى تاريخ مصر الإسلامية.
العادة أن تقدم العيدية للصغار كي ينفقوا منها في أيام العيد، لكن العيدية قد تهدى للزوجة، أو للأم، تأكيدًا على الفرحة بمقدم العيد. وكانت أم أحمد عاكف قد تعودت أن يعطيها كل واحد في الأسرة نصف جنيه عيدية. تفرح بعيديتها فرح الأطفال، وتنفقها كما ينفقها الأطفال، فتشترى ما تشتهيه نفسها من الشيكولاتة والملبّس.
ولأننا نصنع مظاهر الاحتفال بالمناسية الدينية، استمرارًا لموروث يعود إلى بداية التاريخ المكتوب، وإن تجسد بصوره الإسلامية منذ الفاطميين، فإن روح العيد تسري في كل شئ، ترى في الألوان، وتسمع في الجو، وتشم مع الهواء. وأفراد الأسرة يملأون الشوارع بثيابهم الجديدة، والأطفال يعدون هنا وهناك بثيابهم المزركشة ذوات الألوان الفاقعة، تتطاير
وراءها الضفائر والشرائط، وتعلو الزمارات، ويفرقع البمب، وتلوك الأفواه الحلوى والنعناع، وتتردد الأناشيد والأغنيات، وتومض صواريخ العيد والبمب والبالونات الملونة، كما تعلو الأضواء الملونة والغناء في ساحة العيد، يتخللها زعيق العيال والنفخ في المزامير وضرب الطبول ورقص الشباب. كما تمتلئ عربات الكارو بالصبية والبنات، يغنّون ويرقصون ويطبّلون.
في قصة يوسف الشاروني” العيد” تأكيد للمعنى بأننا نحن الذين نصنع العيد، تصنعه ظروفنا المادية، وحالتنا النفسية والصحية. فإذا كان ذلك كله ناقصًا أو مهتزًا أو غير موجود، فإننا نتفهم قول الخالة بحسرة بالغة : ” بكرة العيد .. هه .. العيد ؟!.. بكرة يوم القيامة “!
أهلًا بالعيد!