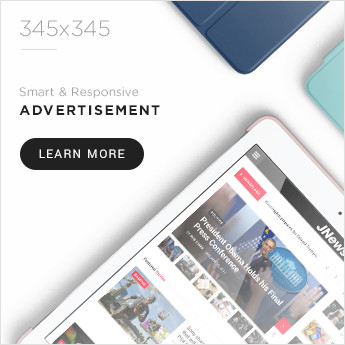لعلي أوافق المؤرخ الإنجليزى جوردونتشايلد رأيه في تفسير التاريخ، وأنه من الصعب – إن لم يكن من المستحيل – قراءة تاريخ غير مشوب بالتحيّز، فالمؤرخ بشر، وهو خاضع لظروف عديدة، وعوامل متباينة، من بينها مصالح الطبقة التي ينتمى إليها، والمناخ الاجتماعي، والحزب – أو التنظيم – الذي يمثله.
نحن نلحظ – مثلًا – في كتابات معظم المؤرخين المصريين الذين عرضوا لثورة 1919 – مقدماتها وأحداثها ونتائجها – أن رؤيتهم للثورة كانت من زاوية محددة، هي – في واقعها – رؤية الحزب الذي ينتمون إليه، ويعبّرون عنه، فأيديولوجية عبد الرحمن الرافعي، وتفسيره لمقدمات الثورة وأحداثها ونتائجها، هي أيديولوجية الحزب الوطني، وتفسيره للثورة. ويعرض العقاد لتلك الأعوام الملتهبة – في أكثر من مؤلف – على ضوء إيمانه بزعامة سعد زغلول، ويناقش د. هيكل ذلك كله من وجهة نظر الأحرار الدستوريين.
وإذا كانت الحيدة ضرورة حتمية في تناول الفنان لأحداث التاريخ [ والمقصود بالحيدة هنا، أن يتجرد الفنان من كل عاطفة خاصة، ثم الحرص على عرض الواقع بأمانة وتجرد ] فثمة فارق بين تناول أحداث التاريخ بموضوعية، وإبداء رأي ذاتي في تلك الأحداث. كتب هوارد فاست رواياته التاريخية عن توم بين وسبارتاكوس وغيرهما، من وجهة نظر ماركسية. كما عبّر برناردشو في أعماله عن انتمائه للاشتراكية الفابية.
ليس مما يعيب الفنان حسه الوطني – على سبيل المثال – ولا نظرته التي تعبّر عن اتجاه مذهبي عام، وعلى حد تعبير هوارد فاست، فإن أيإنسان لا يستطيع أن يستبعد تمامًا عنصر الضرورة من عمله، وليس في إمكان أي إنسان أن يحرر نفسه من العصر الذي يعيش فيه، أو البلد الذي ينتمي إليه، كما أنه لا يستطيع أن يخلق نموذجًا لا يكون للتعليم والدين والسياسة والعادات والفنون في عصره نصيب فيه. ومهما يكن الفنان خياليًا، فإنه لا يستطيع أن يمحو كل أثر للأفكار التى نما عمله فى جوها.
يحدد تشيخوف علاقته بشخصيات قصصه بأنه يهتم بهم جميعًا باعتبارهم بشرًا” وهى في أن أعرض للشخصيات والمواقف بطريقة مقنعة، فلست رجل حزب “، ذلك لأن الفنان لا يكتب منشورًا حزبيًا، ولا يعبّر عن وجهة نظر سياسية، وإنما يقدم عملًا فنيًا، برغم ما يذهب إليه بعض النقاد من أن أسلوب تناول الفنان للتاريخ يختلف تمامًا عن أسلوب المؤرخ، وأن الفنان حر في اختيار أبطال قصصه، وفي وضع هالات القداسة فوق رءوسهم، أو انتزاعها.
إن تحريك الشخصيات، بحيث تؤيد موقف الفنان السياسي، وليس تعبيرًا عن طبيعة هذه الشخصيات، تزييف لوظيفة الفن. الفن الصادق ينزع القشور المذهبية والطائفية والطبقية عن ذاته، من خلال نماذجه.
ليس إبداء رأى الفنان بواسطة شخصياته، دون تقيّد باحتمال طبيعتها لهذا الرأي، وليس التحليل السياسي، سمة العمل الفني، مهما كانت درجة اعتناق الفنان لفكرة سياسية، أو لمذهب.
وإذا كان دفاع ثروت أباظة عن الطبقات الأعلى في المجتمع المصريقد جعل ” فكر ” الرواية تعبيرًا عن وجهة نظر أبعد ما تكون، حتى عن حيدة الفن التي تنأى به عن التقريرية والمباشرة، وإنطاق الشخصيات بآراء الكاتب، والحفاظ على مسار السرد الروائي، بحيث لا يجاوز ” المقولة ” التي يحرص الفنان عليها.. فإن حسين شكري باشا في رواية إحسان عبد القدوس ” شيء فى صدري ” هو التعبير المجسد لباشوات ما بين الثورتين 1919 – 1952، وهم الذين قامت – بدافع محاربتهم – الحركات السياسية والاجتماعية، ما بين معتدلة ومتطرفة، بدءًا بالأحزاب التي تعلن الوطنية وتضمر العمالة، وانتهاء بالفكر اليساري وامتداداته إلى التنظيمات الشيوعية.
أشار إحسان عبد القدوس إلى تصور البعض ” حين نشرت هذه الرواية – والكلام لإحسان -أننى كتبتها عن حياة المليونير أحمد عبود بالذات، وهذا غير حقيقي، لأن حياة أحمد عبود – رغم اتفاقها فى كثير من التفاصيل مع أحداث رواية شيء فى صدرى – لا تفترق عن حياة أكثر من مليونير مصري غيره ( لم يكن الأثرياء المصريون قد دخلوا مغارة المليارات بعد! ) ساروا فى نفس الطريق: التعاون المبكر مع الإنجليز، ثم السيطرة الاحتكارية على الحياة الاقتصادية والحزبية فى مصر، وإفسادها فسادًا لا مكان معه للنجاة إلا بالثورة، وهو خطأ ارتكبته كل الأحزاب الحاكمة بلا استثناء، حين استسلم كل منها لواحد، أو أكثر، من هؤلاء المليونيرات الذين ارتبطوا بالوجود الاستعماري. حزب الوفد كان له مليونيراته، والأحرار الدستوريون، حتى السعديين والكتلة الوفدية، حزب واحد نجا من هذا الوباء الاقتصادى القاتل، ربما لأن قيادته ألزمت نفسها منذ البدء بنوع من التشدد، يقترب من التصوف السياسي، هو الحزب الوطني “.
ولعل تلك الإشارة مما يصح تسميتها إثبات النفى، فأغلب الظن أن ” باشا ” شيء فى صدرى هو تلك الشخصية الواقعية في حياة الاقتصاد المصرى، والذي بدأ حياته خريجًا في مدرسة الفنون والصنائع، المدرسة نفسها التي تخرج فيها بطل رواية عبد القدوس، ثم اقترن بسيدة اسكتلندية سهّلت له صفقاته وارتباطاته، وحمته بنفوذها من المؤامرات التى تهددته، وهو أيضًا ما أقدم عليه بطل الرواية.
كان أحمد عبود متزوجًا من سيدة اسكتلندية شديدة الذكاء، قوية الشخصية، وكان صديقًا للسفير البريطاني رونالد كامبل. وقد اشترى عبود 5874 فدانًا فى أرمنت من الكونت فونتارس – أو الفيكونت هنري جبريل – وهو الاسم المدون في عقد الملكية – اشتراها بما عليها من منشآت ومخازن ومنازل وحظائر وأشجار ونخيل ووابورات بستين ألفًا من الجنيهات. ولم يكن أحمد عبود يختلط بالفلاحين، وكان يعطى كل سلطاته لمفتش اسمه عبد الرحمن عرفات، يساعده عشرة نظار، يراقبون سير العمل فى أراضي التفتيش.
كان عبد الرحمن يعامل المستأجرين معاملة قاسية، ويسيء إليهم، ويهددهم، حتى تربص به مزارع فى عام 1950، وانتظر إلى أن ودع زوجة عبود عند المرسى، وأطلق عليه رصاصة أردته قتيلًا، وألقي القبض على ثلاثين فلاحًا، لم يفرج عنهم إلا بعد إلصاق التهمة باثنين من الخفراء، برأتهما محكمة النقض.
وكان عبود يحتكر – وعائلته – صناعة السكر، وعلى تجارة الجملة فيها، ويلجأ إلى نفوذه في تطويع القرارات الحكومية لخدمة مصالحه، فكميات السكر التي يتم توزيعها بالبطاقات، تحدد بما يدفع المستهلك إلى الشراء بالسعر الحر، والضرائب تلقى تهاونًا فى تقديرها وتحصيلها، وربما سقطت بالتقادم. فإذا لوّحت إحدى الحكومات بتحصيل ضرائب متأخرة، بادر إلى افتعال أزمة في الكميات المطروحة لتقلع الحكومة – من ثم – عن تنفيذ قرارها.
وكان أسلوب تكوين الشركات، والمضاربات، وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين، وخفض الأسعار ورفعها، وشراء الذمم، والرشاوى، والمضاربات.. ذلك كله كان القاسم المشترك في الشخصيتين: الروائية والواقعية.
كان أحمد عبود وراء نظام محمد محمود ونظام إسماعيل صدقى، حتى أنه قام – كما يقول اللورد كيلرن – فى صيف وخريف 1934، بنشاط دعائى واسع فى لندن، لنظام حكم سنة 1930. وقبل عامين أنشأ جريدة ” الكشاف “، لكنها ولدت ميتة، بعد أن خسر أكثر من 20 ألف جنيه ( ثروة هائلة آنذاك! ). وأذاعت محطة الشرق الأدنى أن أحمد عبود باشا قدم رشوة للملك فى جنيف، بوساطة إلياس أندراوس باشا، قدرها مليونا جنيه، ثمناً لإقالة نجيب الهلالى. أصر الهلالى على أن يسدد عبود للدولة ما عليه من ضرائب، فقدم عبود إلى الملك مبلغ الرشوة، فأقال الملك الهلالى، وعين وزارة جديدة برئاسة حسين سري.
أغلب الظن أن شيء فى صدرى هى عرض روائي لحياة تلك الشخصية التي قامت بدور يصعب إنكاره في الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر، ووصل نفوذها حد إسقاط وزارات، وتشكيل وزارات أخرى موالية، والاعتصام وراء نفوذها أمام كل محاولة لمناقشة الحساب.
وكانت الثورة التى قامت في 23 يوليو 1952، انتصارًا مؤكدًا لمحمد أفندي السيد، ذلك الموظف الصغير الذي استعصى على حسين شاكر، وتعفف عنه، ومن ثم حاول أن ينتقم منه في أسرته.
***