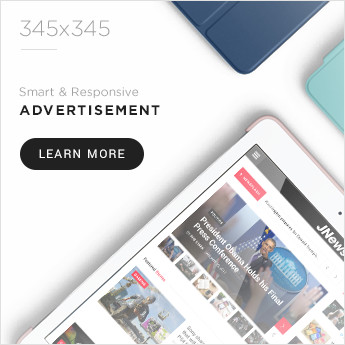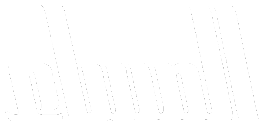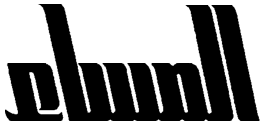بقلم ✍️ أحمد رفاعي آدم
(أديب وروائي)
الماضي طاقة متجددة لا تنفد. فيه الذكريات التي تنعشنا وتطلق فينا روح الحياة، وفيه التجارب التي نتعلم منها ما وسع لنا التبصر والتعلم، وفيه “نحن” يوم كنا صغاراً نرقبُ الأحداث من فوق رصيف الحياة ولا نملك سوى أن نخزنها في ذاكراتنا لنسترجعها وقتما يشغلنا الحنين إليها.
وفي دفترِ الماضي عثرتُ على تلك واقعة مثيرة لفلان (دون ذِكر أسماء)، فماذا حدث؟.
المكان كالمعتاد قرية الحريزات الغربية في سوهاج، والزمان تقريباً في أوائل التسعينات، يعني أيام سقوط إمبراطورية الإتحاد السوفيتي وتفكك بلدانه. وعلى ذكر الإتحاد السوفيتي كان “فلان هذا” (بطل قصتنا) من أسرة كبيرة (متحدة) يحكمها أبٌ صلب له حضوره الذي يشبه إلى حدٍ كبير حضور السيد أحمد عبد الجواد في فيلم بين القصرين (أقصد سي السيد)، وتقوم على شئونها أم خفيضة الجناح طيبة القلب، ويتكون أفرادها من صِبية (جمع كلمة صبي) على مشارف طور المراهقة والفتوة مبعثرين بين الكدح في الغيطان (غيطانهم، لإنهم الصراحة كانوا مبسوطين وعندهم أطيان) والرمح في الشوراع واللف وراء منتخبات القرية في الألعاب المتنوعة من أول “شندر” التي كنا نلعبها ونجري فيها من أول البلد لآخرها ونختبئ في أماكن لا يتخيلها عقل (غير العقل الصعيدي) حتى أن فلان هذا كان يختبئ في الجبابين وتحت كوبري الترعة الحلوة ووسط الغيطان في عز الليل، مروراً بلعبة “اللقُم” والتي تشبه إلى حدٍ كبيرٍ (وبدون مبالغة) لعبة البيسبول الأمريكية، وانتهاءً بلعبة الكون الشعبية “كرة القدم”، والتي كانت تنتعش دورياتها أثناء الانتخابات البرلمانية، فكان منتخب الحريزات لا يكل من السفر والتنقل بين البلدان والقرى المجاورة (أولاد علي، الدويرات، الزارة، الزوك، الشواولة) من أجل اقتناص اللقب. الله يرحمها أيام.
وفي يوم من الأيام المدرسية كان “فلان” هذا يقف فوق كبري الترعة المرة منتظراً السيارة الربع نقل التي تقل منتخب الحريزات -وقد كان صاحبنا من كبار المشجعين أو بمعنى أدق كان فتوة المنتخب حين تحتدم المعارك مع جماهير الفرق المنافِسة، لذلك كان حضوره لا غناء عنه. وكان انتظاره قبيل العصر فصادف خروج الطلاب من المدارس.
ومن يعرف تاريخ الحريزات الغربية وعاصر تلك الفترة الذهبية لها يعرف جيداً أن مدرسة الحريزات الغربية الإعدادية بنين (والتي كان ولا يزال موقعها في شِق السوق) ومدرسة الحريزات الغربية الإعدادية بنات (والتي كانت تقع عند مدخل القرية قبل أن تُهجر وتُبنى مدرسة جديدة عوضاً عنها) كانتا تستقبلان طلاب وطالبات القرى المحيطة من النجيلة والزوك الشرقية غرباً، والحريزات الشرقية والعصارة شرقاً، ونجع الحامدية والعلانية والسِدرية شمالاً، مما جعل قريتنا المبجلة منارةً للعلم وقِبلةً للمتعلمين. ويعلمُ الله كيف كانت هاتان المدرستان بمثَابة قصرين شامخين للتربية قبل التعليم، وكيف كنا نتشربُ القيم والأخلاق في كؤوس المحبة والرِفق والإخلاص بأيدي معلمين ومعلمات أقل ما يوصفون به أنهم عظماء يصدُقُ فيهم قول أمير الشعراء (كاد المعلم أن يكون رسولاً)، ولكَمْ أتمنى أن تعودَ تلك الأيام الغوالي لنمرغ وجوهنا في ثرى خيراتها.
نعود لصاحبنا “فلان” والذي تصادف وقوفه لحظة خروج طلاب المدارس ولإن ذلك الكوبري يقع عند آخر حدود القرية غرباً فقد كان لِزاماً على طلاب وطالبات قريتي الزوك والنجيلة أن يمروا عليه في طريق إيابهم من المدرسة. وبينما هو سارحٌ في انتظاره بجلبابه البلدي الفضفاض وشومته الغليظة إذ مرت به طائفة من فتيات النجيلة ويبدو أنهن كنَّ جميلات مليحات أو خُيِّلَ إليه ذلك وهو يراهُن بعين المراهق الجائع فقد أخذ منظرهن بلُبه وجذبن ناظريه، ولإنه كان ولداً طائشاً لا يحكمه عقلٌ أو يزجره أدبٌ فقد تمادى في بصبصته وجعل يطلق عبارات الغزل والمعاكسة ولم يرعوي بل تجرأ وسار خلفهم حتى حدود الغيطان قبل أن يعود وقد انتشى بفعلته المخزية وراح يستعيد لذة تصرفه الأحمق الذي لا يمتُ للأدب أو الرجولة أو الشهامة بصِلة.
وعلى هذا المنوال جعل المراهق الطائش قليل الذوق يتصيد الفتيات كل يوم عقب انتهاء اليوم الدراسي فيترصدهن فوق الكوبري ثم يتبعهن بكل وقاحه حتى حدود قريتهن المجاورة. ولم يكن عسيراً على الفتيات الصغيرات أن يدركن وقاحة سلوكه وأن يفطِنَّ لخطورة صنيعه المُخزي فتباحثن الأمر واتفقن على إخبار أحد معلميهن ومصارحته بما يصنع ذلك الأرعن قليل الأدب عديم التربية. ولشد ما كانت صدمة ذلك المعلم (كما أخبرني فهو الذي حكى لي هذه الواقعة بنفسه) فقد غضب لكرامة هؤلاء الفتيات وأخذته الحَمِيّة فقرر أن يخرج قبيل انتهاء اليوم المدرسي ليختبئ قريباً من المكان الذي يتخذه (فلان) محطةً يبدأ منها معاكساته ليرى بعينه ويتأكد بنفسه قبل أن يثأر لهنّ. وقد كان! ورأى فلان يكرر صنيعه الشائن ككل يوم ولكن المعلم المحترم لم يدعه يُكمل نوبته المخزية ففاجأه بظهوره وتصدى له ونهره قبل أن يعقِدَ العزم على إخبار والده. وحسناً فعل!
فبعدما اطمأن المعلم لمغادرة الفتيات أخذ بمجامع الفتى وقاده أمامه كمجرم قُبض عليه مُتَلبساً ومضى به إلى دار أبيه، وهناك التقى بوالده فشكى له ما كان منه ولشد ما كانت صدمة الأب وهو يسمع ما يندى له الجبين وتستحي منه الأذن. فشكر للمعلم حرصه واعتذر ما وسع له الاعتذار وطلب الصفح والغفران. وبغض النظر عن ردة فعل الأب، وبغض النظر عن رؤيته في العقوبة المناسبة التي حكم بها على ابنه، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نعترف بأن ما قام به مع ابنه حماه ووقاه ولقنه درساً لم ينسه. ولقد رأيت ذلك ال “فلان” في زياراتي للصعيد فإذا به بخير حال وقد صار أباً لفتية وفتيات حسني التربية جميلي الطباع.
فأما ما فعله أبوه فلا يُنسى. بعد درس في الأخلاق دفعه إلى سطوح الدار حيث قيَّده كالأسرى ثم ربطه في قائم خشبي كبير. كان ذلك بعد العصر! ولقد تركه على تلك الهيئة مدة ليست بالقصيرة. بقى فلان في مربطه ذليلاً وحيداً بلا طعام أو شراب طوال النهار حتى أقبل المساء فظنَّ أن وقت سراحه حان لكن هيهات فقد أبى والده إلا أن يُبيِّته في مطرحه مُكَبّلاً ليذوق وبال فعلته الشائنة. وقد كان! فقد قضى فلان ليلته في محبسه بين دموعٍ لا تتوقف وإحساسٍ بالندم لا يترفق، فكان إذا لم يسعفه الدمع ضرب رأسه في القائم الخشبي، وإذا آلمته رأسه عاد لبكائه. وظل على حالته تلك حتى غلبته عيناه فنام حتى مطلع الشمس لم يوقظه إلا حرارتها فعاد لما كان فيه من العذاب. وربما ظلَّ على ذلك المنوال أيام لولا شفقة أمه التي لم يُجدِ تشفعها عند زوجها فلبست بردتها (والبردة غطاء أسود كبير كانت تلتحفه النساء في الصعيد إذا خرجن من بيوتهن فيغطيهن من قمة الرأس إلى أُخمص القدم، وكان لشدة اتساعه يستوعب امرأتين معاً). فلبست بردتها ومضت إلى بيت المعلم فقابلته بدموع الرجاء وكلمات التوسل وقصَّت عليه ما كان من زوجها مع ولدها، ولشد ما كانت صدمته من ذلك العقاب المرعب فلم يتوان عن الخروج معها من فوره ومضى إلى الشيخ يستسمحه ويرجوه الصفح عن ابنه. وأمام توسله الحار وتشفعه المخلص وافق الأب فعفا عن ابنه بعدما أحضره ليقبِّل رأس ويد الأستاذ معتذراً منيباً عازماً ألا يعود لفعلته ما طلعت عليه شمس، وهو ما كان من فلان بالفعل. فقد مضت السنون كيفما اتفق للزمان أن يمضي، ودارت الأيام في ركب الحياة وظلَّ صاحبنا فلان بعد تلك الحادثة على عهده من التربية وقد تدرج في الأدب والاتزان حتى تزوج وكوَّن أسرة رائعة وها هو اليوم يقف عند طور الجدودية (أي يوشك أن يصير جداً لو أن ابنته الكبرى تزوجت).
ونعود لحاضرنا فنتساءل كيف هي التربية اليوم؟ وكيف حالنا مع أبنائنا وكيف حالهم معنا؟ ألسنا نعيش في زمانٍ يعزُّ على المُسيء فيه أن يُعاقَب والمخطئ أن يُلام؟ إنني أؤمن بمقولة من أَمِنَ العقوبة أساءَ الأدب، وأؤيد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب دون إفراطٍ أو تفريط، لا سيما ونحن نعيش في زمن العولمة، زمن الانفتاح، زمن المد الفكري الغير مُنَقّح أو محكوم. لا شك أن التربية صعبة، ولا شك إنها مسئولية قاسية، لكن تبقى واجباً لا مفر منه، وضرورةً لا غِناء عنها. يا سادة، كلنا راعٍ وكلنا مسئول عن رعيته أمام الله، فلنقم بواجبنا ولنضطلع بدورنا ولنؤدي مسئوليتنا دون نكوص أو ملل مهما كان الأمر شاقاً، فعلى قدر المشقة يكون الأجر.
انظر كيف انتهى الأمر بفلان ولو أنه لم يُعاقب منذ بادئ الخطأ لما اعتذر وأناب، وبصِدقٍ استدار وعاد إلى جادة الصواب. لا أقول أن نفعل كما فعل به أبوه فلكل زمان عاداته وتقاليده، ولكل مكان قواعده وقوانينه، ولكني ألفِتُ النظر إلى أهمية متابعة الأبناء ومواكبتهم في تصرفاتهم لتقويم سلوكهم عند الخطأ ولتعزيزه عند الصواب. لا جِدال في ضرورة اصطحاب أبنائنا في رحلة الحياة فهم يستحقون ونحن أهلٌ لذلك.
رحِم الله الماضي بتاريخه التليد وأحداثه الخالدة وحفظ أبناءنا من كل شر ووفقنا إلى حُسن تربيتهم والاعتناء بهم.