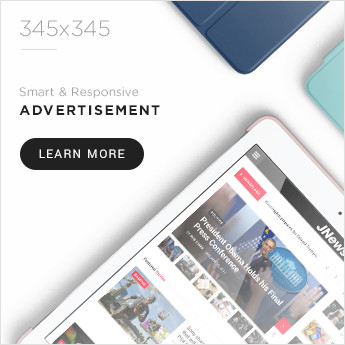قاومت ظروفي الصحية، وعدت إلى الإسكندرية. لاحظت – والسيارة تنطلق في طريق الكورنيش – أن مئذنة أبو العباس لم تعد تعلو وحدها في الفضاء الفسيح، حاصرتها أبراج وبنايات مرتفعة، فهي تعانى. ربما لو أنى لم أترك بحري، ما لاحظت الاختفاء، التلاشي، الذى ابتلع الكثير من البنايات والشوارع والميادين. حتى الميدان الأشهر الذى يطل عليه جامع السلطان، تبدّلت هيئته، فقد توسطه مبنى هائل، تحولت أطراف الميدان من حوله إلى شوارع صغيرة، ضيقة، واتصلت – بالكاد – بما كان قائمًا من الشوارع الجانبية.
أقول: ربما لو أني لم أترك بحري، وأعود إليه، على فترات متباعدة، ما لاحظت ذلك التبدل في قسمات الحى.
أنا أتبين – في كل عودة إلى بحري – ما لم أكن لاحظته من قبل.
ربما لم أكن أكتب عن بحرى كل هذه الصفحات، بكل هذا الحب، لو أنى ظللت في الحي، لم أبتعد عنه. الابتعاد يتولد عنه الذكريات والشوق والحنين وغيرها من المشاعر التي تستفز المبدع في داخلي. الصور التي أشاهدها وأنا أجول في شوارع بحري وأزقته، تختلف تمامًا عن الصور التي أستعيدها وأنا في مكتبي.
في داخلي حنين إلى دنيا لم تعد موجودة، دنيا الموالد والأذكار والجلوات وسوق العيد وحفلات الزفاف والختان والخيام والبيارق والأعلام والدفوف والطبول والأدعية والأناشيد والأهازيج. غابت تلك الدنيا في غابات الأسمنت التي تلاصقت، حتى في ميدان أبو العباس الذى لم يبق منه سوى الاسم.
إسكندريتي ليست البنايات الضخمة على الكورنيش، ولا في الميادين والشوارع الفسيحة. إنها البيوت الصغيرة، المتلاصقة، والشوارع الضيقة، المتقاطعة، تتراكم فيها مياه الأمطار، تختلط بالتراب، فتصنع ما يشبه كومات الطين، تعلو فتهبط أبواب البيوت تحت مستوى الطريق. وثمة القهاوي والغرز والأضرحة والزوايا، ومدرسة البوصيري الأولية، وروضة مصر الفتاة، وكتاب الشيخ أحمد، والمذاكرة في صحن أبو العباس، وقلعة قايتباي، والبيت المهجور بشارع سيدي داود، أهرول أمامه لتصور أن الأشباح تسكنه، ونادى مدرسة إبراهيم الأول، وخطب الشيخ عبد الحفيظ، وتياترو المسيرى، وفرقة فوزى منيب، وحديقة سراي رأس التين، وجياد الملك في جولاتها الصباحبة، والمظاهرات الصاخبة لا أعرف من أين جاءت، ولا إلى أين تنتهي، تهتف بسقوط الملك وزعماء الأقلية، وبحياة النحاس، وصيد العصاري، وحلقة السمك ورائحة الزفارة والعطن وأريج البخور والكتاتيب والصوفية والموالد وحلقات الذكر والأهازيج، والوقفة أسفل بواخر البوستة الخديوية، ومباريات الكرة في الأراضي الخلاء، وقهوة فاروق، وشهبور الحلاق، وحلواني الطيبين، وسباق البنز والطائرات الورقية والجبب والقفاطين وملاءات اللف.
زمان، وأنا أصعد الترام المتجه إلى محطة القطار، خطفت نظرة من الشقة في البيت رقم 54 شارع إسماعيل صبري، النوافذ والشرفات التي أطللت منها على المشهد الذى أحبه، في داخلي شعور بأني مسافر بلا عودة، تفتح لي القاهرة حتى الباب الواحد والأربعين الذى يجب أن يظل مغلقًا.
ثمة تكوينات ومنمنمات تصنع فسيفساء المشهد: صيد المياس أوقات العصر، سمي صيد العصاري، آخر معارك الفتوات في ميدان ” الخمس فوانيس”، خطب الشيخ عبد الحفيظ في صلاة الجمعة، يأتي إليها المصلون من أحياء المدينة، ومن المدن القريبة، لعب الكرة في الشارع الخلفي، نواهي أمي ترفض الفكرة، ثم يتاح لي اللعب بإشفاق أبي، الجلوات القادمة من أبو العباس، تخترق شارع الأباصيري إلى ميدان “الخمس فوانيس”، تميل إلى شارع إسماعيل صبري، ثم شارع الميدان، لا أعرف أين تنفض، أعرف نهاية الجنازات: الصلاة في جامع الشيخ إبراهيم، ثم تتجه إلى مقابر العامود، سوق العيد بصخبه وزحامه وألعابه، يبدأ أول رمضان، يمتد إلى ما بعد أيام العيد، الرويعي الترزي فى جلسته الثابتة أمام الدكان، لا تفلت امرأة – ولو سحبت حفيدها – من معابثاته، محمود أفندي جار البيت المقابل، مثل لي جثمانه الملتف بالكفن عقدة عانيتها طيلة عمرى، موقف عربات الحنطور على ناصية إسماعيل صبري من ناحية التتويج، بيت الأوقاف القديم، فاطمة أول تعرفي إلى الدنيا الغامضة، النافذة قصاد النافذة، البنت تنبهني إلى ما يغيب عني، تمط شفتها السفلى في خيبة أمل، وتغلق النافذة، دكان الطيبين الحلواني، يسدل الستارة الحديدية، أعرف أن الرجل يسوي خلطة الهريسة السحرية، السرية، على المياه الساخنة، لا يأذن حتى لعماله بالمتابعة، عيادة الطبيب الأرمني الدكتور مردروس فى الطابق الأول من البيت، أتاح لنا التمورجي – في أوقات غياب الطبيب – ما اخترعناه من ألعاب، تعكس بقايا تأثيرات الحرب العالمية الثانية، جعلت الرجل – بما رواه أبي عن حياته – بطلًا لروايتي” صيد العصاري”، عم أحمد بائع ألواح الثلج، صندوقه الضخم لصق الجدار، أول شارع فرنسا، وسيلة تبريد الماء، وحفظ الطعام، في زمن الثلاجة الخشبية، أي التي بلا كهرباء، المظاهرات الحاشدة تأتي من ناحية باب الجمرك رقم واحد، تتشابك السواعد، وتنشد الصفوف: بلادي بلادي بلادي.. لك حبي وفؤادي، سيارات الجيش الإنجليزي يجري وراءها صبيان الفتوات، يقفز أحدهم داخلها، يقذف – في غيبة من انتباه السائق – ما تحمله إلى زملائه في نهر الطريق، آلاف الوفديين يحيطون بسيارة فؤاد سراج الدين، إلى جواره رفعة الزعيم الجليل في عربة مكشوفة، يحتفون بعودته من رحلته العلاجية بهتافات وأهازيج وأغنيات، بائع الصحف على ناصية الطريق، أشتري منه – كل صباح – ما يعرف أن أبي يقرأه من صحف عربية وأجنبية، الجريدة بخمسة مليمات، غالبية الأسماء غابت بتغير المشهد السياسي وغياب الإسكندرية الكوزموباليتينية: الأهرام، المصري، الاشتراكية، المقطم، البصير، البورص، الإجبشيان جازيت، البروجريه، إلخ. أميز الشيخ فتوح من صوته المسرسع، أتابع خطواته المترنحة تحت ثقل المخلاة فوق ظهره، بها – أتصور – ما يقدمه له الخيرون من أطعمة، وما ييسر حياته، متابعتي – من خصاص النافذة المغلقة – منشد الأهازيج في مشواره اليومي، قبل صلاة الفجر، عم عبده في دكان بيع السجاير، أمامها طلمبة بنزين وحيدة، يفسر أبى إغلاق الدكان والطلمبة – أحيانًا – بأن الرجل أخفق في الحصول على الكيف.
طال ابتعادي عن البيت والشارع، أعود في فترات متباعدة، لكن رائحة المكان تظل في أنفي، أميزها بصعوبة، لكنها موجودة، تلامس أنفي بتداخل روائح مختلفة، اختلاط ملح البحر واليود والبخور وزفارة السمك والطحالب والأعشاب، تصنع رائحة تعيدني إلى الحياة في بحري.
إذا كان قد خطر لي – أحيانًا – أن أدخل البناية رقم 54 شارع إسماعيل صبري، أصعد إلى شقة الطابق الثالث المجاورة للسلم، أستعيد ملامح وذكريات، فإن الخاطر نفسه راودني أن أدخل واحدة من البنايات المواجهة للمينا الشرقية، أطل من نافذة على أفق البحر. المحيط الجغرافي – على حد تعبير إيزابيل الليندي – هو الذى يحدد شخصية الإنسان.
لعل البحر في مقدمة ما أفدت من تأثيره، ليس البحر في إطلاقه، وإنما أفق البحر، حضه على التأمل بما لا يحضرني في موضع آخر.