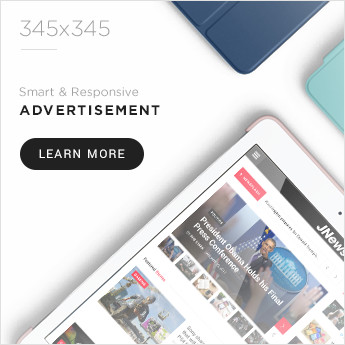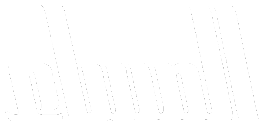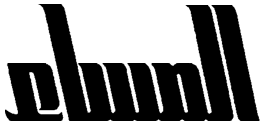بقلم/ أحمد رفاعي آدم
(* شاعر وأديب)

اللغة مرآة الأمة الصادقة التي تعكس صورتها الواقعية وهي المؤشر الحساس الذي يقيس مستوى ازدهارها علواً وهبوطاً، فقوة اللغة وانتشارها دليل تقدم الأمة ورِفعة شأنها، وتراجع اللغة وهامشيتها دليل ضعفها وتقوقعها وانسحابها من الساحة العالمية.
والحمد لله أولاً وأخيراً الذي تكفَّلَ بحماية اللغة العربية بحفظٍ من عنده إذ يقول جل وعلا “إنا نحنُ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”، وحِفظُ الذكر دليلٌ ضمني قاطع على حفظ اللغة العربية إلى أن تقوم الساعة فهي لغة القرآن الكريم ولغة الحساب ولغة أهل الجنة إن شاء الله.
وأمام تلك المعطيات ندرك أهمية اللغة العربية و صلابتها ومدى إبائها على الزوال والانقراض، لكن ذلك لا ينفي على الإطلاق تعرضها للضعف -أو بالأحرى- الإضعاف بين الحين والآخر. وما عصر الاستعمار الإنجليزي منا ببعيد، ففي تلك الفترة السوداء من تاريخ مصر تعرضت اللغة العربية –شأنها في ذلك شأن أهلها- لمحاولات الكسر والإذلال بل ومحاولات التشويه والإساءة لأجل إضعافها والتخلص منها، فقال المستعمر عنها أنها لغة لا تصلح لمواكبة عصر العلم والتطور وحاول جاهداً أن يقنع أهلها بالتخلي عنها بالإستغناء عن العربية الفصحى والاكتفاء بالعامية فطلب من القائمين على الأمر وقتها أن تُعتَمد اللهجة العامية لغة المراسلات والكتابة فقوبل مكرُه بالصد والرد والهجوم المعاكس من قِبل المصريين الشرفاء سياسيين وأدباء وشعراء وعامة فأبوا عليه مكره وردوا عليه كيده وانطلقت الحشود الواعية تدافع عن الفصحى وتدعو للتمسك بها وعدم الاستغناء عنها.
وكلنا نتذكر رائعة شاعر النيل حافظ إبراهيم “اللغة العربية تنعي نفسها” والتي قال فيها بيته الشهير “أنا البحرُ في أحشائه الدُّرُ كامنٌ .. فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي”. ذلك البيت الذي تحولَّ في زماننا بقدرةِ قادر إلى مقطع ساخر في أغنية فيلم منذ سنوات حتى أنك لو سألت كثير من شباب اليوم عنه لما صدَّق أنه بيت في قصيدة عربية بالفصحى.
أما بعد،
فحريٌ بكل عربي عاشق لعروبته وأمته أن يدرك “غلاوة” اللغة العربية وأن يفطِنَ لمحاولات أعدائها للنَيل منها، فالمخاطر التي تحدقُّ بنا وبهويتنا وبثقافتنا وبكل ما يمتُّ لنا بصلة كثيرة، وأغلبها خفيٌ يعزُّ على الأبصار والأفهام. ومن أشد تلك المخاطر مصيبة إزدواجية اللغة عند الأطفال، تلك الإزدواجية التي تعدت حد تعليهم لغةً أجنبية منذ نعومة أظفارهم إلى التركيز على تلك اللغة وإهمال اللغة الأم، فأصبح كثيرٌ من الآباء والأمهات يتفاخرون بتعليم صغارهم الإنجليزية والفرنسية وغيرها ويتنافسون على إلحاقهم بالمدراس الدولية “ليرطنوا” بتلك اللغات دون أدنى مبالاة وحرص على إتقانهم للغة العربية. فما عتم أن خرج جيلٌ يُتقنُ اللغات الأجنبية ثم لا يخجل من نفسه –بل أحياناً يفخر- أنه لا يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية. أي مصيبةٍ وأي كارثةٍ حطت على لغتنا العربية. لم يستطع الاستعمار بجلالة قدره أن ينزع تقديرنا لها فإذا بالزمن يدور دورته وإذا بنا نتخلى عنها بأنفسنا وبكامل إرادتنا.
وليس ذلك ذنب التعليم الدولي، فما الضرر من التعليم الحديث الراقي؟ بل ليت تعليمنا المصري يرتقي فيبلغه في مستواه، إنما الضرر كل الضرر في الاقتباس بلا تفكير والتقليد بغير بصيرة. ولشد ما يحزنني كمعلم أن أرى جيلاً لا يعرف قدر لغته الأم ولا يبالي إن هو أتقنها أم لا، ولا تهتز له شعرة وهو يقول بـ”الفم الملآن” أنا لا أحبُّ اللغة العربية!! إنه استعمار بشكل جديد!!
فما العمل؟ في رأيي هناك الكثير ليُعمل. وأكبر المسئولية يقع على الآباء والأمهات فمن عندهم تبدأ القصة. ربوا أبناءكم على حب اللغة العربية وعلموهم أصولها ليتقنوها وبينوا لهم عظيم قدرها وجلال مكانتها بين لغات العالم. إنها واحدة من أهم لغات الأرض وأعظمها، لغة يتحدث بها ما يفوق المليار ونصف، لغة لم تتأثر بصروف الدهر ولا بتقلبات الزمن، لغةٌ شامخة لم تفقد هويتها رغم كثرة الحوادث وعداء المعتدين، لغةٌ كُتِبَ وأُلِّفَ بها الألوف المؤلفة من الكتب في شتى المجالات وفي كل بقاع الأرض. إنها اللغة العربية ولا فخر! لغة القرآن الكريم. يكفي أن تعلم عزيزي القارئ أنها واحدة من اللغات التي لا يخلو منها قسم اللغات في أي جامعة أمريكية فهي واحدة من اللغات التي يطلقون عليها Critical Languages أي اللغات بالغة الأهمية! وهذا ليس تخمين أو افتراء اختلقته بل هي الحقيقة التي رأيتها بنفسي أثناء إقامتي بالولايات المتحدة.
يكفي أن تعلم أن على مدخل مكتبة جامعة ييل العريقة Yale University وهي أعرق وأقدم وأفخم جامعة أمريكية أول سورة العلق ونص آية الكرسي مكتوب باللغة العربية. تُرى، لو لم تكن اللغة العربية عظيمة هل كانوا سيفخرون بوجودها على بوابة إحدى أكبر مكتباتهم؟! أشك.